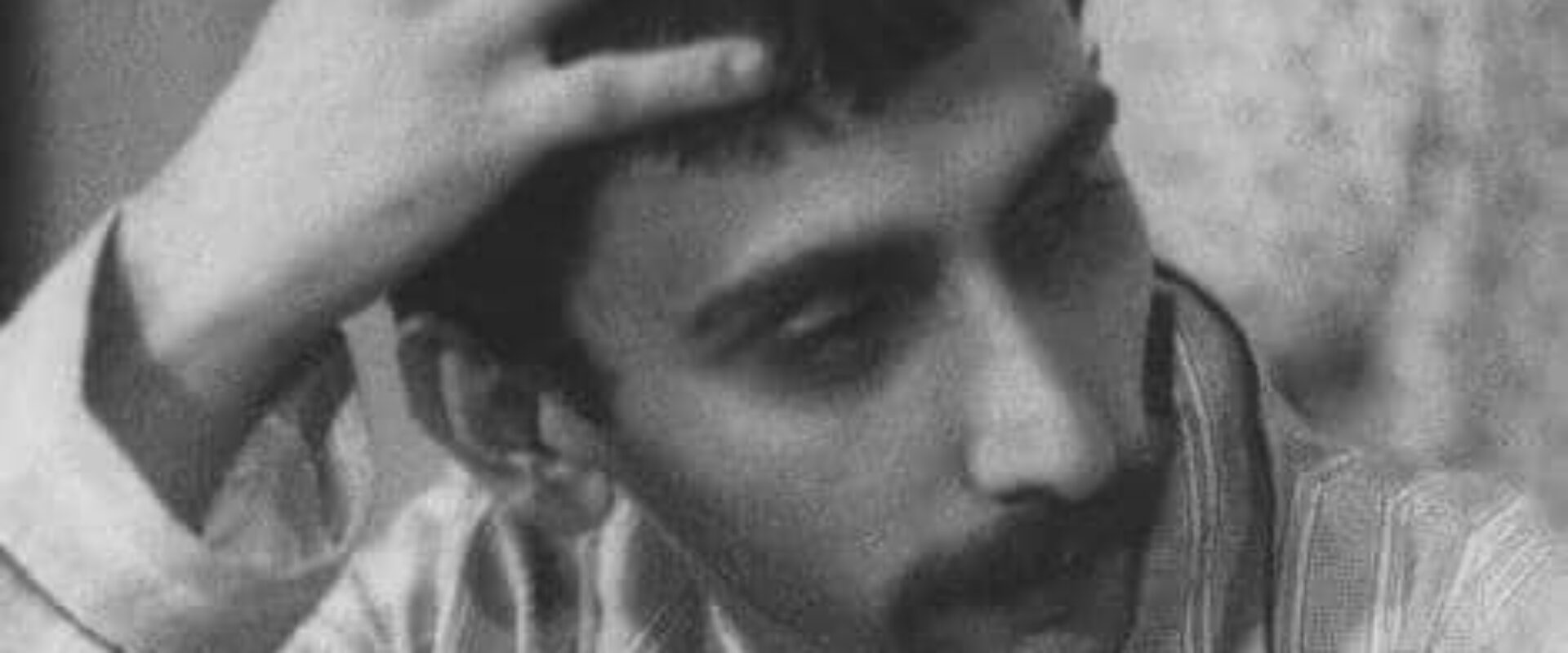
تعرفت على زياد الرحباني، كما العديد من الناس، عن طريق صديق شيوعي في المدرسة، وأحببت أعماله مع أنها بدت شبه ارتجالية، وغير متناسقة غالبًا، ولم أستطع أن أحدد سبب تعلقي المضطرد بأعماله إلا بعد عقدين من الاستماع إليه، وثورة، وحرب، والكثير من الفقد والأحزان والأفراح.
استحضر الأخوان الرحباني لبنانًا من الطيور المغردة والينابيع الكريستالية، وقرىً لا فقير فيها، وحيث لم تُخترع كلمة الطائفية بعد. عندما أصيب والده عاصي بجلطة دماغية عام ١٩٧٢، انضم زياد الشاب بشكل طبيعي إلى عمل العائلة، وعندما طلبت منه فرقة مسرحية تعيد إنتاج مسرحيات الأخوين الرحباني كتابة عمل أصيل، ألف عمله الأول سهرية، بمثابة تكريم خالص شبيه بأسلوب الرحباني في جوهره، كلها قصص بسيطة وألحان عذبة.
بحلول عام ١٩٧٤ انقلبت الأمور. أعلنت نزل السرور عن زياد مختلف تمامًا؛ قضى بقية مسيرته الفنية كقاتل فني، يخنق بحب الجمالية التي غذته. فبينما غنى والداه عن التراث، سخر من “الفولكلور المخدر للعقل”؛ وحيثما احتفيا برومنسيةٍ بحياة القرية، خلق شخصيات تتعاطى التقاليد كما لو كانت حشيشًا، فتُخدر نفسها عن الواقع؛ ونصحت أغنية الزفاف الأطفال بـ “إنتاج جمهور ثوري”، وعدم “عبادة لبنان” كما قد وعظ والداه يومًا. الأخوين الرحباني، موسم العز.
أيقظت الحرب الأهلية في نفسه شيئًا لا يرحم. كان لبنان الذهبي الذي استحضره والداه، ذلك الفردوس الجبلي، يتمزق بفعل الانقسامات الطائفية ذاتها التي تجاهلها بعناية فائقة. احتاج الصراخ بالحقيقة. هكذا أصبح أعظم مُحطّم للأصنام الموسيقية في لبنان، مُستخدمًا موهبته كالمطرقة. كانت مسرحياته روائية لا ملحمية، متجذّرة في غموض الحاضر المُربك بدل بساطة الماضي النبيلة.
لم تحتو تحفته الفنية عن التدمير، شي فاشل (١٩٨٣)، على أي أغنية كاملة في نكتة مسرحية ميتافيزيقية. في هذه المسرحية هجومه الأكثر مباشرة على مشروع الرحباني، حيث أظهرت شخصيات تقليدية تواجه مخرجها بشأن تقادم فنها المُسلّع.
“الغريب هو نحن”، هكذا أعلنت شخصياته، رافضةً خيال والديه المُريح بأن مشاكل لبنان تأتي من الخارج. أما في فيلم أمريكي طويل، وضع شخصياته في مستشفى للأمراض العقلية، مشيرًا إلى أن المجانين المفترضين هم الوحيدون الذين يستجيبون بعقلانية لجنون لبنان. لم يكن السجناء مجانين؛ بل البلد هو المجنون. هجومه الأكثر وحشية على فكرة أن الفن يجب أن يُهدئ بدلًا من أن يثير.
مع كل تمرده، ظل زياد أسيرًا لـ أمة الرحبانية. كانت تلك معاناة زياد الرحباني الجميلة. خبيرًا في الهدم وعالم آثار في آنٍ واحد، يُحطم خيالات والديه ويحافظ على فتاتها بعناية. عام ١٩٩٥، رتّب سبع عشرة أغنية من أكثر أغاني الأخوين رحباني رومانسيةً ريفيةً في ألبومه التكريمي “إلى عاصي”، محتفظًا بكل كلمة من كلمات الأغاني التي قضى عقودًا في تقليدها.
لم تكن علاقته بإرث عائلته قط قطيعة صريحة، بل تناقضًا أبديًا. كما لو أنه لا يستطيع كبح جماح نفسه، وكأن تيارًا أعمق ظل يجذبه إلى الشواطئ ذاتها التي أقسم على التخلي عنها.
ربما كانت هذه أعمق رؤاه: أننا جميعًا أسرى القصص التي تُكوّننا، حتى عندما – وخاصةً عندما – نقضي حياتنا في محاولة إعادة كتابتها. لم يكن “الحنين الحداثي” الذي ميّز أعماله اللاحقة حنينًا إلى ماضٍ لا يُعوّض، بل إلى الأوهام والرغبات التي كانت ممكنة في ذلك الماضي. لم يكن يتوق إلى لبنان خيالي، بل إلى إمكانية الإيمان ببراءة كهذه مجددًا.
كلام زياد
إذا كان السجن الأول مصنوعًا من الأغاني، فإن الثاني بُني من الكلمات نفسها. اكتشف زياد أن اللغة، مثل لبنان، قد استُعمرت من قِبل طغيان صوت واحد منمق. حاول والداه ابتكار “لغة عربية لبنانية” نقية كقراهم الجبلية، مُنقّاة من الفوضى الجميلة التي جسدت لغة البلاد الحقيقية. إلا أن زياد شرع في تحرير اللغة بحماس مقاتل فدائي.
“كلام زياد” Haugbolle, Sune. The Leftist, the Liberal, and the Space in Between: Ziad Rahbani and Everyday Ideology. Arab Studies Institute. The Arab Studies Journal. Vol. 24, No. 1. Spring 2016, pp. (168-190). كما سموها – هذه اللهجة الهجينة التي أطلقها على المسرح، مازجًا اللهجات الجبلية الطويلة باللهجة العامية الحضرية، مُنكّهًا العربية الفصحى بألفاظ فرنسية بذيئة وعبثية إنجليزية.
تحدثت شخصياته كما يتحدث اللبنانيون الحقيقيون: في تناقضات، بلغات متعددة في آن واحد، في نشاز جميل لبلد لم يُقرر بعد ما يريد أن يكون؛ واستمتع بتصوير شخصيات تفتقر إلى مهارات اللغة الأجنبية، أو مدير يتبنى لهجة خليجية لإرضاء المستثمرين، مسلطًا الضوء على الواقعية اللغوية والتعليق الاجتماعي. حتى أنه سخر من الشعر المتكلف والخطاب الصحفي، مفضلًا التواصل المباشر والصادق.
بينما قدّم والداه الوحدة اللغوية، احتفى زياد بالفوضى اللغوية. أصبحت مسرحياته مختبرات لهذه اللغة الجديدة، وأصبح مسرحه نوعًا من دور العبادة المضادة حيث لا يأتي المصلون للعبادة بل للتعرف على أنفسهم.
عالم زياد
زخر عالم زياد بشخصيات مميزة، وتشبع بمعانٍ تتراوح بين البسيطة والعميقة. إلى جانب عائلته المباشرة، ساعدته شخصيات مثل جان شمعون رفيقه في ريادة التعليقات الإذاعية الساخرة خلال الحرب الأهلية، وهي نقد يومي لاذع يخترق فوضى الحياة والحرب؛ وأصبح جوزيف صقر، بصوته البلدي (الفلكلوري)، وسيلة زياد لمحاكاة الأغاني التي سعى لتفكيكها.
قرأ بيرتولت بريشت، وتأثر بلغة الشارع لكتاب المسرحيات الفرنسيين أمثال مارسيل باجنول، حتى أنه اقتبس أعمال موليير. ومن المرجح أن الفيلسوف الماركسي روجيه غارودي قد عزز قناعاته الاشتراكية، بينما كان المغني اليساري خالد الحبر من أوائل المتلقين لأغانيه الاحتجاجية.
هجر منزل العائلة، مقارنًا ذهابه وإيابه بكريستوفر (وارن كريستوفر، وزير الخارجية الأمريكي، ودبلوماسيته المكوكية) Stone, Christopher, Popular Culture and Nationalism in Lebanon, 2008, Routledge، وهي تفصيلة شخصية غريبة ذات دلالة عميقة. مزج التوترات الطائفية الحقيقية بين ممثليه في مسرحياته، طامسًا الخطوط الفاصلة بين الفن والواقع الممزق في الخارج؛ وأحجم عن التعامل مع الصحافة، رغم استمراره في الكتابة لصحيفة الأخبار، ما يرسم ملامح شخصية متحفظة تُفضل التحدث من خلال فنها.
لجغرافية حياته أهمية مماثلة. عُرضت مسرحيته الأولى في قرية بقنايا الصغيرة، لكن بيروت، وتحديدًا غرب بيروت خلال الحرب، كانت بوتقة إبداعه الفني. استضاف مسرح أورلي الكبير نجاحاته المبكرة، وبثت إذاعة لبنان وإذاعة صوت الشعب اليسارية تعليقاته اللاذعة. كان حصار ومجزرة مخيم تل الزعتر للاجئين الفلسطينيين مؤثرًا بشكل كبير في صحوته السياسية. حتى بعلبك، القلب النابض لـ أمة الرحبانيين لوالديه، أصبحت مسرحًا لمحاكاة ساخرة خاصة به، مكانًا ساهم فيه وانتقده.
وصف زياد نفسه بالماركسي، ودعم الحزب الشيوعي، ودافع عن مقاومة حزب الله رافضًا أيديولوجيته. لكن سياساته الأصيلة كانت جمالية: إصراره على أن الفن يجب أن يزرع “بذرة الأفكار الثورية”، وأن الجمال المنفصل عن الحقيقة ليس سوى شكل آخر من أشكال القمع.
علمته الحرب الأهلية أن الواقع يضرب كالقنبلة – فجأةً، لا لبس فيه، يستحيل التخلص منه شعريًا. حاول والداه صنع فنّ يتجاوز السياسة؛ أما هو، فقد صنع سياسةً لا مفرّ منها. في النهاية، كان ابن لبنان الأكثر صدقًا – صادقًا جدًا لدرجة أنه لم يقبل ميراثه، مقيدًا بالحب لدرجة أنه لم يتخل عنه تمامًا. عاش فنه في تلك المساحة المستحيلة بين السخرية والإخلاص، بين حلم والديه وكابوس الوطن.
ظل زياد الرحباني عصيًا على الالتقاط كذكريات الطفولة السعيدة. كان يختفي لسنوات، متجنبًا الصحفيين لما أسماه “أسبابًا سياسية ونفسية وصحية”، ولا يظهر إلا عندما تتفاقم تناقضات لبنان لدرجة يصعب تجاهلها. أصبح غيابه بحد ذاته حضورًا، وصمته تعليقًا على بلدٍ أتقن الحديث خارج ذاته.
فيروز
تجرأ زياد على فعل شيء ملهم. تجرأ على أنسنة والدته. أصبحت فيروز أكثر من مجرد مغنية؛ ذلك الملاك المُحاط بهالة في المجاز الوطني، ومريم العذراء على موجات الأثير. لا يمكن المساس بها، وبالتالي، في نظره، ميتة فنيًا. أغرى قديسة لبنان العلمانية بالنزول عن مكانتها لتغني عن الحب الرومانسي الراشد وفوضاه الحقيقة، وعن الحياة اليومية، وعن الرغبة التي تطلب من الله أن “يخرب بيت” عيني الحبيب. كان ذلك تدنيسًا من أرقّ أنواع الإهانة – ابن يُحرر أمه من سجن أسطورتها الرخامي.
كانت المفارقة بديعة: ففي محاولته تحريرها من سجن، ربما يكون قد بنى لها سجنًا آخر. تساءل النقاد عما إذا كانت قد استبدلت دولة الرحبانية بجمهورية زياد، مستبدلةً شكلًا من أشكال الأسر الفني بآخر. لكن ربما أخطأوا في فهم الغاية. ربما لم تكن الحرية، لشخص مثل فيروز، غياب القيود، بل القدرة على اختيار القفص الجميل الذي تسكنه.
عاش زياد الرحباني عالقًا بين الهدم والبناء، بين لبنان الذي كان ولبنان الذي كان من الممكن أن يكون. لقد قضى حياته المهنية محاولاً إيقاظ بلاده من أحلامها، ليكتشف أنه هو الآخر كان يحلم – يحلم بلبنان صادق بما يكفي ليعترف بكذبه، معقد بما يكفي لاحتضان تناقضاته، شجاع بما يكفي ليتوقف عن التظاهر بأنه شيء مختلف عما هو عليه.
أمضى عقودًا يُعلّم فيروز الغناء عن الرغبة الإنسانية، عن فوضى الحب الحقيقي، عن ثقل العيش في جسد حقيقي بدلًا من التحليق فوق لبنان كروح حامية. الآن عليها أن تحمل تلك المعرفة وحدها، العضو الأخير الباقي من ثالوثٍ حدّد أحلام أمة ثم فكّكها منهجيًا. الأيقونة والمرأة، الرمز والأم، الأبدي والمؤلم المؤقت. بفقدانه، أصبحت ما كان يُخبرنا به دائمًا: جميلة، مأساوية، وإنسانية تمامًا.