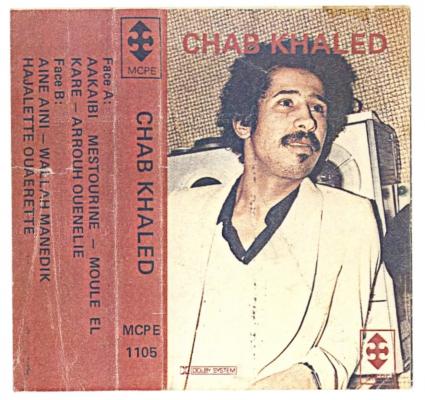
هكذا تكلّم الشاب خالد
صلاح باديس ۲۰۱٤/۰٤/۱۵
ستوكهولم ٢٠١٠
يعتلي رجل مسرح الحفل في ستوكهولم العام ٢٠١٠ ليسلّم على خالد قبل أن يبعده الأمن، وقبل أن يغادر المسرح يتكلم في الميكروفون طالباً أغنية لله يا جزاير، ولكنه يقول: “يا جزاير يا وردة الروح” صارخاً: vive l’Algérie و“الله يرحم الشهداء“. ينظر بغضب لرجل الأمن ويبعده عنه، ويلوّح بالعلم للجمهور وينزل الى مكانه. بالنسبة لشخص غير جزائري سيبدو الخطاب الصغير للرجل مشوشّاً وغير متناسق: أغنية عن الوطن. هُتاف شعبي عن الوطن، وترحّم على شهداء الثورة الجزائريّة.
بعدها يبدأ خالد في غناء آخر أغنياته المشهورة في تلك الفترة: لا ليبرتي la liberté. الموسيقى قويّة، لكن الكلمات تحمل رائحة كلام الرجل السابق: مشوّشة ومبهمة ومغرقة في الرمزيّة. إذ نفهم من الكلمات أن الراوي يشتكي من امرأة سحرته ويريد الفكاك منها، متحدّثاً عن معاناته، في الغربة غالباً. ولكن أيّة محاولات لشرح الكلام تنسفه وتفقد الأغنية سحرها، خاصة أن السحر يكمن في تدوير خالد– وهذه هي عادته– لكلمات مثل: أنا يانا أو رايي أو اللي كواتني à moi la liberté . شيء يتقنه تماماً مثل الاستخبارات الطويلة التي يصدّر بها أغانيه في الحفلات (الاستخبار في الموسيقى الأندلسية مثل الموّال الشرقي).
ثمّة مشكلة بين الإحساس والتعبير بين فيض المشاعر والنقص في وسائل التعبير عند الرجل وعند خالد، لكن نوع الغناء الذي يغنيه خالد لا يمكن أن يكون أوضح من ذلك، فالأغنية تستند إلى الموسيقى، والإيقاع، والكلام المبهم والغريب، بحيث يصبح فيه واللامنطوق أكبر مما قيل، مثل: ديدي، عندما نقرأ الكلمات نجد أنها كليشيات تتردّد في أغاني الراي خلاصتها التعبير عن الحب على الطريقة الجزائريّة. لكن المميّز عند خالد هو أنه “يغنّي” الإخفاق والعذاب وتآمر العديان (اليد الخارجيّة المجهولة في كل أغاني الراي) على العاشقين. أي أنّه لا يبكي على الأطلال، بل ربما هناك رغبة مضمرة في الانتقام. المساحة التي بين التعبير و الاحساس لا تشكّل مشكلة لخالد لأنّه يتكلم ويفكّر بنفس الطريقة. وفي حين يغطّي هذه المساحة بصوته القوي عندما يغني، يغطيها بضحكته “البلهاء” عندما يتحدث. عندما يغني أغانٍ مبهمة المعنى، والتي يمكن وصفها بالتجاريّة، يعبّر عن نفسه بأفضل طريقة. ولو سئل عن الكلمات لحاول الشرح بجديّة تامة.
في الأسطوانة الأخيرة، ‘c’est la vie’، ظهرت أغنية ثنائيّة مع المغني البورتوريكي بيتبول: “هي اللي بغات“. في حين غنّى بيتبول بنفس الإيقاع والكلمات التي ظلّ يرددها في أغانيه مع نجوم آخرين، استعمل خالد كلمات جديدة، جعلت الجميع يتساءل عن المعنى المُضمَر خلفها، خاصة أنها حملت إيحاءات جنسيّة صريحة. موضوع الأغنية –كالعادة– المرأة القوية، الجامحة، صعبة المنال. يقول أنّه أراد أن يخطبها بشكل عادي لكنّها تركت الدار وخرجت عن أهلها، إذ لا يهمها عيب ولا عار. حتى الآن الأمور معتادة بموسيقى إلكترونيّة قويّة، ثم تنفجر الموسيقى ويبدأ خالد بالصراخ: هي اللي بغات (في العاميّة الجزائريّة في الغرب تحديداً: هي التي أرادت أو أحبت)، وتبقى هذه العبارة تتردد. ثم يدوّر الـ“هي“، وأخيراً يُفرج عن الشيء الذي رغبت به: داي داي داي؟ لاي لللاي للللللاي؟ والتي فسّرت على أنّها أرادت: “الجنس“؟ أرادت الطريقة الصعبة في حل الأمور؟
أما في أغنية c’est la vie، والتي حملت الأسطوانة اسمها فنجد نفس صورة العاشق التي كرّسها خالد لنفسه على مدى عقود من الغناء. ويؤكد ذلك افتتاحه للأغنية بعبارة: راني ما نادم على ليام اللي لعبت بيك وبيا (ليس نادماً على ما فعلته الدنيا به وبحبيبته على مرّ السنين). ولكن الكلام يأخذ منحى آخراً وإشارات غير مفهومة عن هذه الحبيبة، وتنتهي المقاطع بقفلات غريبة هدفها الوحيد مواكبة إيقاع الموسيقى التي تغطي على كل شيء. يدعو خالد في الأغنية إلى الاحتفال والغناء والرقص، وكنجم يحترم الشيب الذي في رأسه، اكتفى بمتابعة فرقة الرقص من بعيد، من مكان أعلى. ولكن الذي أثار الناس، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي هي عبارة: “لازم الجرح يبرا بالدوا“. إذ من الطبيعي أن يبرأ الجرح بالدواء، علّق البعض ساخرا من الكلمات، والتي ظلّت منذ أن غنّى “ديدي” العام ١٩٩٢، تتعرّض لنقد ساخر.
باريس/ الجزائر نهاية الثمانينيات
يترك خالد الجزائر بعد مهرجان موسيقى الراي العام ١٩٨٥ حيث أعطي لقب ملك الراي، ليصل إلى فرنسا متعاوناً مع الجازمان صافي بوتلة، ويُصدر أسطوانة “كوتشي” (الكاليش أو عربة الأحصنة بالإسبانيّة). ومن هناك، يخرج الراي للعالم، وينتشر اسم خالد ويظهر في الصحف والمقابلات التلفزيونيّة. ومع ازدياد حضوره الإعلامي، تتزايد زلات لسانه (يتكلم الفرنسيّة بتراكيب عربيّة)، بينما يزداد تذمر الناس من ظهوره المتزايد في التلفزيون الفرنسي. في مقابلة معه يتحدث عن أحد الموسيقيين، و عندما يريد أن يستشهد بما قاله ذلك الشخص، يقول: comme il a dit lui ! ، “كما قال هو“، (الأصح: كما قالcomme il a dit/) لتلتصق العبارة به، وتأتي أغنية “ديدي” العام ١٩٩٢، بكلماتها التي تشكل كولاج غريب لعبارات قديمة وأخرى جديدة، لتدعم الصورة الكاريكاتيريّة التي رسمها الناس عن خالد.
لكن النجاحات التي كان يحققها غطّت على كل التعليقات الساخرة، واقتصر افتتان الشباب بأغاني خالد “الجديدة” على الموسيقى فقط، فالكلام والأغاني العاطفية كانت مُحتكرة من طرف نجم آخر: الشاب حسني. كان الظهور القوي للشاب حسني صادماً، بدأ نجم هذا المغني الشاب لطابع الراي العاطفي يلمع في وسط الحراك السياسي للبلاد وصعود الإسلام السياسي، وبعدها دخول البلاد في “عشريّة الدم“، والتي أجهزت على بقايا الوعي بالأنا والآخر لدى الإنسان الجزائري. في تلك الفترة الصعبة، كان حسني ينتج بغزارة وكأنّه رد فعل فني على الحالة الراهنة للبلاد وصل حتى لإنتاج أسطوانتين في اليوم نفسه (وهذه مسألة تتعلق بالمنتجين الذين استغلوا شهرته لتحقيق مكاسب شخصيّة). في المقابل، كان الشباب يستقبل هذه الأعمال بنهم كبير، ومثلما ثوّر (أو عَصْرَنَه) خالد الراي وأدخل عليه الريغي والرّوك والجاز، ثوّر حسني الأغنية العاطفيّة الوهرانيّة، وأخرج مزيجاً لا زال يفتن الناس إلى يومنا هذا. الكلام في أغاني حسني كان قويّاً، خاصة في أغانٍ مثل: “طال غيابك يا غزالي“، أو “ما تبكيش” أو “وعلاش يا عينيا“. لكن نجاح حسني السّاحق داخل البلاد، لم يكن ليقارن بنجاح أغاني خالد في العالم، إذ كان اغتيال الشاب حسني في ٢٨ أيلول/ سبتمبر ١٩٩٤ سبباً في توقف هذا النجاح. لكن حتى لو عاش حسني لن يكون بإمكاننا المقارنة، فهناك عبارة يرددها الناس للتفريق بين اللون الذي يغنيه كل منهما: “خالد غنّاي وحسني بكّاي“.
ستوكهولم مرة أخرى
يتكلّم خالد ابتداءً من الدقيقة السابعة عن بداياته: “أظن أنّي ولدت موسيقيّاً، منذ صغري وأنا أصنع آلات موسيقيّة بوسائل تقليديّة. كنت أحب أن أجرب صوتي في الحي، كنا صغاراً وكنا نجلس تحت النوافذ ونغني كي نجذب أنظار البنات رغم أنّنا لم نكن نفهم ما هو الحب، ولكنّه كان شيئاً بريئاً“. يبتسم ويتابع: “لكن الطفل دائماً ما يُغرم بشيء ما، ومن دون أن يعلم ما هو، وشكراً للرب على نعمة الحب والتعاسة، حتى أننا عندما نخرج من بطون أمهاتنا نبكي“. ثم يتحدث عن والده الذي عارض حبه للموسيقى، وعلّل هذه المعارضة بقوله أن الذي يمشي في هذا الطريق سيغرق في المخدرات والكحول“. هنا تنقبض ملامحه ويكمل: “لا زواج، لا أولاد لا حياة (كأنّها القصة التي تحكيها أغنيته “داتني السْكرَة“)، ثم أننا لم نرى فنانا ينجح في الجزائر“.
خالد في هذه الدقائق الثلاث غير خالد الذي نعرفه، ربما لأنه تحدث عن الموسيقى وعن بداياته، إذ يبدو مرتاحاً وناضجاً: “الحياة هي من ربتني“، غالباً ما يكرّر هذه العبارة في السنوات الأخيرة، خاصة عندما يتكلم عن الحب الذي يبدو كمن عرفه عن حق. لكنه لا يرتاح و ينسجم مع نفسه إلا على المسرح عند أدائه لأغانٍ مثل ‘oran-marseille’ أو ديدي أو يا رايي، يبدو كأنه يعيش الأورغازم الخاص به، يبتسم و يضرب بيده على فخذه متابعاً الإيقاع. يصل الأمر حتى أنه يقلد صوت ينبح كجروٍ في الميكروفون على عادة مغنيين البلوز السود في الثلاثينيّات عندما تشتعل القاعة ويشتد العزف.
الأغنية الأحجية
الشيء اللّافت عند خالد هو أنّه كشف أوراقه منذ البداية، ومن دون قصد. راهن على موسيقى جديدة وكان كذلك، ولكنه لم يتكلم يوما عن مشروعٍ فني أو حاول التنظير له، حتى بكلماته البسيطة. ربما يعود ذلك لتكوينه وطبقته الاجتماعيّة التي ينحدر منها، فما يزال خالد هو ذلك الفقير الذي يغنّي ليعيش تحت المفهوم الحرفي الكبير: الموسيقى هي الخبزة، لكن في نفس الوقت، ذلك لا يمنعه من الاستمتاع بما يفعله. على الرغم من الأغاني التي يصنفها البعض على أنّها تجاريّة – والتي صار مستواها ينخفض في السنوات الأخيرة، خاصة إذا ما قارناها بما غنى في التسعينيّات، وخاصة أسطوانته الأبرز صحرا (١٩٩٦) – ظلّ خالد يفاجئ الجمهور بأغانٍ مذهلة، خاصة عندما غنى للراحل أحمد وهبي: بختة، والتي بدا فيها وكأنّه يعيد تعريف الأغنية الوهرانيّة. وحتى أغانيه الخاصة التي تشبه الأحجية التي تتكوّن من مقاطع مغنّاة كالشذرات ترابط معانيها أو تقاربها ضعيف وهش، ولكنّها تدور حول متن الأغنية أو محورها، وغالباً ما يكون ذلك المحور هو العنوان.
لذلك تبقى مساحة اللاّمنطوق كبيرة ومثيرة، ليكمن جمال الأغنية هنا: لا يُمكن أن يُقال أكثر. وهنا أذكر أغنية البابور قلّع التي غنّاها لفيلم المخرج الفرانكو–جزائري رشيد بوشارب indigènes العام ٢٠٠٦. الفيلم الذي يحكي قصة المغاربة والأفارقة الذين جنّدتهم فرنسا في حروبها مع ألمانيا وفيتنام. عندما أسمع الأغنية أحسّ أني أغترب داخل خرافة، أكاد أرى السفينة الكبيرة والرجال بسترات كالحة أصغر من مقاسهم، وأحذية بالية، يحملون حقائب تآكلت حوافها وهم يعبرون الجسر الخشبي الى السفينة، تحت عيون جمارك المُستعمر، يتركون غربتهم الأولى في وطنهم المسلوب قاصدين غربة ثانية.