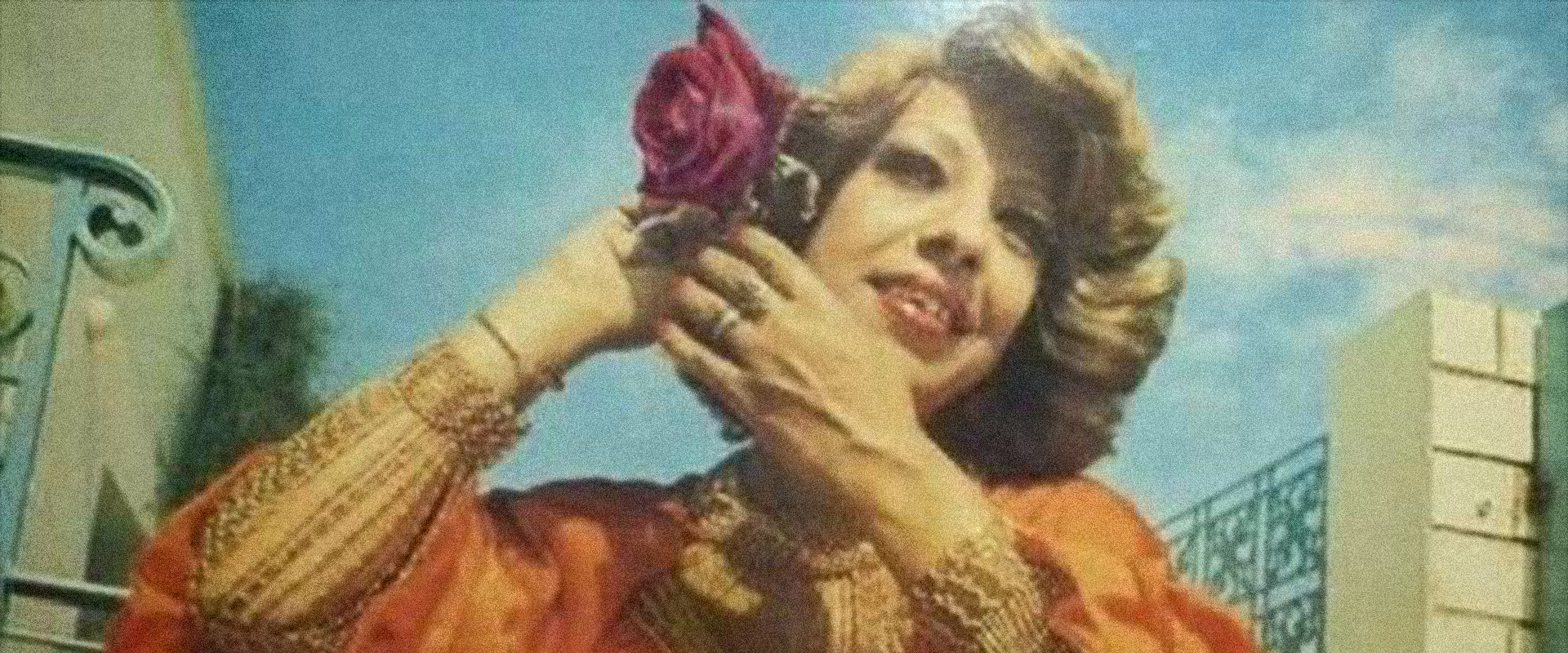
عندما كانت بالكاد في منتصف ثلاثيّنياتها، قررت صفية الشامية (١٩٣٢ – ٢٠٠٤)، أن تكتب قصة حياتها. ربما بحدسٍ عميقٍ منها، كانت تدرك أن سنواتٍ طويلةٍ من الركض بين المسارح والتجارب قد تضيع دون أن يلتفت إليها أحد.
ربما قبل رحيلها منذ عشرين عامًا، تركت أوراقًا مكتوبةً عن حياةٍ، عاشتها بين شواطئ المتوسط وثقافاته، تبحث عن مستقرٍ وهويةٍ. لكنها لم تنشر ما وعدت به. كانت الأيام أشد عصفًا وسرعةً من أن تمهلها وقتًا للجلوس والكتابة.
حين طوى الموت صفحتها، لم يكد المرء يجد عنها إلا القليل من الأخبار ليعيد كتابة تلك الرحلة الملحمية من شواطئ لبنان إلى شواطئ تونس، بهوياتٍ كثيرة، متماثلة ومتنافرة، كأحوال ذلك العصر، الذي فصل بين الحربين وأعقب حروب الاستقلال.
اليوم، عندما يحاول المرء أن يكتب عنها، لا يجد سوى صدى صوتها، الذي ولد من بلدان عديدة، ليستقر وحيدًا في الأرشيف؛ لكن ربما يجد شيئًا آخر لا يمكن أن يلمسه، بل يحسه. إنه البهجة. صورتها، ونمطها، وصوتها واستدارة جسدها على المسرح فيها الكثير من البهجة، التي وجدت طريقها لكل تونسي عرفها شخصيًا أو من خلال أغانيها.
كانت سنديانة بهجةٍ في غابةٍ من مغني الحُزن. إذ كان الحزن السلعة الأغلى في سوق الغناء العربي ردحًا من الزمن، وكانت أم كلثومه تهيمن بلا كلل على المشاعر والآذان والقلوب. لكن صفية ظلت لعقودٍ تزين بصوتها حفلات الأعراس وسجالات الغزل بين المحبين، وركنًا أساسيًا في الرحلات المدرسية. حين يعود الباحث إلى جذورها ربما يكتشف جوهر هذه البهجة.
ولدت شريفة – اسمها الحقيقي – في لبنان عام ١٩٣٢، في عائلة مختلطة. والداها أحمد قنون جزائري هاجر إلى لبنان في عهد الانتداب الفرنسي، وهناك تزوج والدتها التركية، ميريام سود. في مدرسة الراهبات، حيث درست، ظهر شغفها بالموسيقى والغناء. ساعدها في ذلك صداقتها مع نجاح سلام، التي ذاع صيتها بعد سنوات.
كان والد نجاح، محي الدين سلام، عارف عودٍ ويشغل منصب المدير الفني لإذاعة لبنان، ومن خلاله بدأت شريفة في الترددّ على كورال الإذاعة والمشاركة في نشاطه. تقول صفية في مقابلة نشرت قبل وفاتها عن تلك البدايات:
“كانت شقيقتي الكبرى خيرية المسؤولة عن ذهابي وايابي لمبنى الإذاعة، وظللت أتلقى دروسًا شاقة في الموسيقى وفي أصول الأداء على يد محي الدين سلام، حتى جاء اليوم الذي حان فيه أن أغني في الإذاعة. ولأني كنت طفلة وقصيرة القامة فقد استوجب الأمر وضع كرسي أمام المكروفون لكي أصعد فوقه عندما أغني … وقدمت آنذاك عدة مواويل من بينها لالا وهيهات يا بو الزلف وغزالي يا أبو الهيبة وعلى دلعونا.”
لكن البداية الحقيقية لها كانت على يد الملحن المصري عبد الرحمن الخطيب (١٩٢٣ – ٢٠١٣)، الذي سمعها تغني بمناسبة عيد ميلاد شقيقتها خيرية في بيروت، فأعطاها أول أغنية خاصة: حول يا غنّام حول، من كلمات إيليا المتني؛ التي لم تلبث أن غنتها سهام رفقي عام ١٩٤٩، ثم نجاح سلام، وضاعت ملكيتها.
كان ذلك بسبب هجرة شريفة عن لبنان في ١٩٤٦، عندما قرر والدها العودة إلى الجزائر بعد استقلال لبنان؛ وقبل أن ترسوا به السفينة في الجزائر، فضّل المكوث في تونس حتى يستطلعّ الوضع في البلاد. هناك، كانت الأقدار تنسج أثوابها لشريفة قنوّن وعائلتها.
العصفورة تنزل من السفينة
على بحر مضطرب، انزلقت السفينة إلى خليج تونس. وقفت شريفة عند السور تراقب المدينة وهي تتكشف أمامها مثل صفحات كتاب لم تقرأه قط لكنها حفظته عن ظهر قلب بطريقة ما.
لقد غادرت بيروت في أعقاب الحرب، وهي تحمل حقيبة صغيرة واللحن الذي يسكن أنفاسها. قيل لها إن تونس أرض الأبواب المفتوحة لأولئك الذين يستطيعون جعل الهواء نفسه يرتجف بالموسيقى؛ وفي مكان ما في متاهة هذه المدينة، وجدت المكان الذي تتحول فيه الأصوات إلى ذهب.
سكنت عائلة شريفة في ساحة العملة قرب مبنى الإذاعة، لوقتٍ كان مقدرًا أن يكون قصيرًا؛ لكن صار المقام الوقتي في تونس مستقرًا، بعد أن دخل الصراع في الجزائر بين الاستعمار والحركة الوطنية مرحلةً غير مسبوقةٍ بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.
من شرفة الشقة الصغيرة لشقة أحمد قنون، كانت شريفة تذيع كل يومٍ للحيٍ كوكتيلًا من الأغاني اللبنانية الصاخبة؛ والتي وجدت في نفس جارتها اليهودية ريموندا متعةً دفعتها لربط الصلات معها. كانت ريموندا تتمتع بعلاقات قوية بالمشرفين على الإذاعة التونسية، ونجحت بعد عناءٍ في تقديمها إلى مصطفى أبو شوشة، مدير القسم الفني في الإذاعة، الذي أعجب بصوتها، ووجد فيها عنصرًا من شأنه أن يضفي تنوعًا على الإذاعة، لجهة إتقانها الأغاني المشرقية.
في مكتب أبو شوشة اختفى اسم شريفة وولدت صفية الشامية، فقد ألحَ عليها بحمل اسمٍ فني على عادة ذلك العصرّ، واختار لها اسم المغنية التركية صفية آيلا. في الإذاعة، وقف مجموعة من الرجال يستمعون إليها وهي جامدة أمام الميكروفون. يداها ثابتتان، وقلبها ينبض في وجلٍ؛ وعندما فتحت فمها، ارتفعت النغمة الأولى مثل طائر تحرر.
غنت لرجاء عبده البسطجية اشتكوا، وكأن أحدًا لا يقف هناك. عندما انتهت، ساد الصمت في الغرفة بسبب الدهشة، ثم تعالت التصفيقات. بحلول الليل، كان صوتها يتردد في كل أنحاء البلاد.
من بين هؤلاء الذين اكتشفوا صوت هذه الغريبة القادمة من الشرق، كان محمد الحبيب، المدير الفني لـ جمعية الكوكب التمثيلي، أحد أبرز فرق المسرح في تونس في ذلك الوقت. عرض عليها الانضمام لفرقته، ومن خلال الكوكب التمثيلي أًصبحت صفية الشامية على تماسٍ مباشرٍ مع الجمهور، وركنًا أساسيًا من أركان المسرح الغنائي، وشاركت في عروضٍ أبرزها مجنون ليلى وعنترّ وعبلة.
عندما وصلت صفية الشامية إلى تونس بعد الحرب العالمية الثانية، كانت البلاد تشهد حركة فنية كبيرةً، من خلال بروز وتطور الفرق الموسيقية، بعد رسوخٍ عدد من المغنيين في فترة ما بين الحربين، الذين شكلوا فرقهم خاصة مثل عليّ الرياحي وحسيبة رشدي، وفتحية خيري التي كانت الاسم الأكثر شهرةً في ذلك الوقت، والتي قاد فرقتها الملحن المصري سيد شطا.
في فرقة علي الرياحي وجدت صفية مستقرًا لها. هناك التقت لأول مرةٍ مع الملحن وعازف الكمان، أحمد الصبّاحي، الذي لم يعجب فقط بصوتها، بل وقع في حبها وتزوجها. من فرقة عليّ الرياحي، انتقلت إلى فرقة الخضراء التي أسّسها عام ١٩٤٩ الملحن قدور الصرارفي (١٩١٣ – ١٩٧٧)، ثم ما لبثت أن استقر بها الحال في فرقة الصباح التي أسّسها زوجها أحمد الصباحي.
لحن الصباحي لها أغانٍ عُرفت بها في ذلك الوقت، أبرزها سيقارو من كلمات عبد الكريم الحبيب وقالولي أسمر من كلمات الشاعر محمود بورقيبة، وذنب شكون من كلمات حمادي مالك، وكذلك يا سايقين العير وما كنتش نحسب بالمرة.
ربما وجدت في البداية صعوبة كبيرة في نطق اللهجة التونسية بطريقة صحيحة – كما تقول – لكنها تلقت دروسًا كثيرة على يدي صالح المهدي وأحمد الصباحي، وفضلت في النهاية الغناء باللهجة البدوية، التي تمتزج فيها لهجات الشرق والغرب على نحو يصعب أحيانًا تفريقه.
من خلال المقاهي الغنائية (الكافي شانطات) بدأت شهرة صفية الشامية تملأ آفاق البلاد. في صالة الفتح غنتّ صفية ورقصتّ كما لم يغنٍ قبلها أحد. كان أسلوبها الاستعراضي جديدًا، قاطعًا مع أنماط الغناء الصارمة. من الهمسات الضاحكة للجمهور، والتلويح بالأيدي من بعيد والنزول من المسرح والغناء بين الناس، وتدوير السبحة في الهواء، شكّلت بهجتها المتفردة وجزءًا أصيلًا من صورتها وهويتها. تصف صفية الشامية تلك الحالة بالقول:
“يمكنني أن أشبّه نفسي بالعصفور الذي عندما يخرج من قفصه لا يكف عن الطيران والزقزقة … أنا هكذا. فبعد انتهاء الحفل أعود الى البيت ولا أطلب إلا الهدوء والصمت وحتى جهاز الراديو لا أفتحه، وأكتفي فقط بالمطالعة. لكن أمام الجمهور أكون كالعصفورة تمامًا.”
ربما يشير لقب وصف العصفورة إلى شيء كان دائمًا في خاطر صفية، وهو التأثر الشديد بأسلوب الفنانة صباح، التي كانت دائمًا المثال الفني الذي أرادت صفية أن تتطابق معه، وقد أطلق عليها الناس لقبًا حملته حتى رحيلها: لهلوبة المسرح.
سنوات المجدّ والغروبّ
بعد رسوخ أقدامها في تونس، وتدهور الأوضاع في البلاد مطلع الخمسينات بسبب تصاعد الصراع بين الاستعمار والحركة الوطنية، أصبحت صفية الشامية تسافر إلى باريس بشكل دوري.
كانت العاصمة الفرنسية تعيش العصر الذهبي للملاهي العربية. بعد الحرب العالمية الثانية، أصبحت المدينة السحرية ملجأً لعدد كبير من الفنانين من العالم العربي، لا سيما من المغرب العربي والمشرق وتركيا؛ ما خلق مجتمعًا فنيًا في مساحة مشتركة لاستكشاف جذوره وحداثته.
في تلك الفترة ظهرت الأسماء الأسطورية لهذه الصنعة: ملهى الجزائر، الذي استقطب الأسماء الكبيرة للموسيقى الشعبية المغاربية والأندلسية، مثل الشيخ الحسناوي وسليم الهلالي والشيخة ريميتي، والقصبة وبغداد والعديد من الصالات الأخرى، التي اجتذبت بسرعة زبائن ذوّاقة، وجمعت بين وجهاء أثرياء من الشتات العربي، والباريسيين أو السياح الأوروبيين العابرين، في أجواء مصممة بعناية، مع غرابة خيالية تمزج بين الإثارة وعوالم ألف ليلة وليلة.
في صالة تام تام، على مفترق شارع القديس سيفيرين بالحي اللاتيني، سطع نجم صفية الشامية. كان الملهى ملك والدة الفنانة وردة فتوكي (وردة الجزائرية)، ومختصّ باستضافة المغنين من المشرق العربي مثل ليلى مراد وفريد الأطرش.
شكلت هذه الملاهي أكثر من مجرد مكان للسماع والمتعة، فقد وفرت ملجأً للمنفيين وجسورًا بين الثقافات، وربطت بين أوصال العالم العربي، التي مزقتها فترة الحرّب. في تام تام التقت صفية الشامية لأول مرةٍ بفريد الأطرش، الذي عرض عليها السفر إلى مصر. تروي عن تلك الواقعة قائلةً:
“رفضت الفكرة. فقد كان يعز عليّ فراق أمي وأبي وأختي وزوجي وأولادي. كان يصعب عليّ الرحيل عن تونس. يصعب عليّ الابتعاد عن زوجي، الذي كان بدوره يرفض هجرتي إلى مصر، وأنا كنت أحبه حبين، حب التلميذة لأستاذها وحب المرأة لزوجها. وكم تكررت بعدها فرص الهجرة من تونس ولكنني كررت رفضي. وكان فريد الأطرش يزورنا كل سنة ورغم أنه اقترح عليّ التعامل معه فإن عملية التسجيل في باريس حالت دون هذا الأمر لأننا كنا نفتقد لموسيقيين هناك.”
رغم النكبة التي حلتّ بصالة تام تام، وعائلة فتوكي، عندما اكتشفت الشرطة الفرنسية مخزنًا للسلاح في الملهى كان موجهًا إلى جبهة التحرير الوطني الجزائرية، إلا أن مقام صفية بباريس كان مثمرًا ومؤثرًا في بقية مسيرتها، بفضل لقائها مع الملحن والمغني التونسي، محمد الجموسي.
كتب الجموسي ولحن لها وغنتّ معه أشهر أغانيها محلى قدك والله عاجبني، التي عُرفت بها في تونس على نحو واسعٍ؛ وأغانٍ أخرى مثل: يا قلبي ما زال صغير وعمرك ما يتولاه وأوبريت فاطمة.
بعد الاستقلال واستقرار دولة الحبيب بورقيبة، أصبحت صفية الشامية من الفنانين المكرسين، من خلال الحفلات الرسمية وغير الرسمية والإذاعة، ثم التلفزيون منذ نهاية الستينيات. كما انخرطت، شأنها في ذلك شأن أغلب الطبقة الفنية، في الغناء للوطن والزعيم. كان ذلك التقليد عرفًا جاريًا في الأوساط الثقافية التونسية لكسب موقع في المشهد.
منذ نهاية السبعينات، بدأت صفية في التوجه نحو غروبٍ فني، تعزز أكثر في الثمانينات، عندما لم تجد في الغناء طائلًا، فسلكت طريق التجارة خلال فورة صعود القطاع الخاص في البلاد. لتلوذ بعد ذلك بعزلةٍ، فنية واجتماعية، بعد رحيل زوجها أحمد الصباحي.
بحلول التسعينيات، لم تعد تظهر إلا قليلًا. ملأت أصوات جديدة موجات الأثير، وزينت وجوه جديدة شاشات التلفزيون. لم يعد أحد يطرق بابها، إلا أن أغانيها ظلت ترفرف فوق أسطح المدن، حيث تقام حفلات الأعراس، وتتدفق من أجهزة الراديو في المقاهي، ويتردد صداها في المسارح حيث تعيد الأجيال الجديدة غناءها، مفتونين بسحر صوتها.