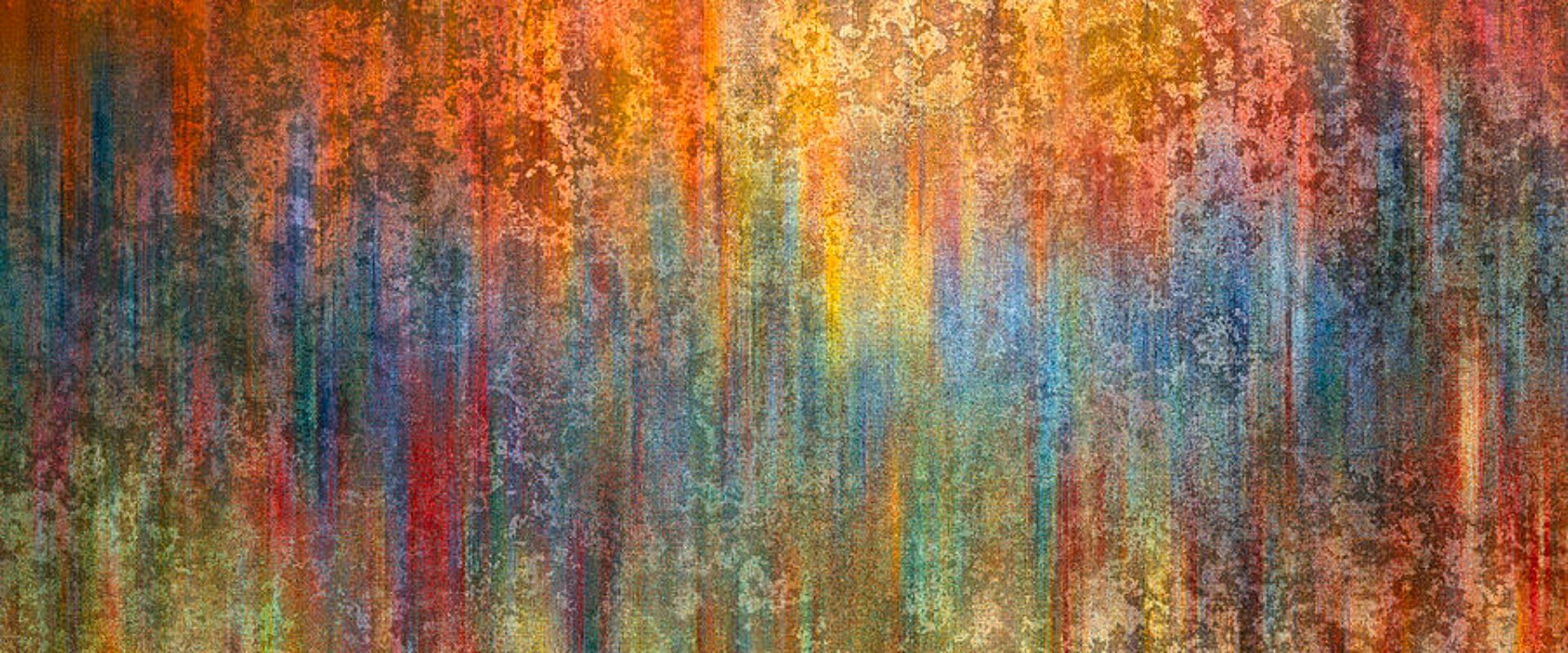
من تعريفات الفن الحديث، الذي شاع منذ انتصاف القرن التاسع عشر تقريبًا بدءًا مما بعد الرومانسية، وامتدّ بعيدًا حتى يومنا الحالي، أنه الفن الذي يخترع موضوعَه اختراعًا. ذلك في مقابل الفن التقليدي، الذي يحاول تقديم موضوع قائم فعلًا في الواقع.
إذا كانت الرومانسية مقارنةً بالكلاسيكية قد قدمت موضوعاتها بتصرّفٍ؛ بهدف التأكيد على أهمية الجانب الذاتي في الرؤية، والمعالجة، فإن الفن الحديث، باختلاف مدارسه، يتجاوز ثنائية الذاتية والموضوعية، ويسعى إلى تأكيد قضية مختلفة تمامًا، هي أن إدراكنا نفسه، الذي نحاول تصنيفه إلى جانب ذاتي وجانب موضوعي، ربما لا يمكنه أصلًا أن يكون موضوعيًا، كي يمكن من الأساس وضع القسمة الثنائية السابقة. من أشهر الأمثلة لوحات بيكاسو، ودالي، وقبلهما فان جوخ؛ فإننا حين ننظر في هذه اللوحات، لا نجد مقابلًا واضحًا لها في الواقع، اللهم إلا على سبيل ما هو عام جدًا من الملامح.
إذا أنعمنا النظر في طبيعة الفن الحديث سنجد ثلاث خصائص أساسية: أولًا: التجريب بما هو فنّ، وهو ما يعني أن التجريب قد توقف عن كونه مجرد مرحلة في بداية تأسيس حركة فنية، وصار هو نفسه الحركة. يذهب أصحاب هذه الرؤية إلى أن التجريب هو أساس الإبداع، وأن اتخاذ نموذج ما بوصفه معيارًا جماليًا هو أمر لا يخلو من ممارسات السلطة الفنية، والنقدية.
أما الخصيصة الثانية فهي العمل الفني كموضوع: وتعني أن العمل الفني لا يصوّر موضوعًا خارجيًا عنه بقدر ما يصير هو نفسه موضوعًا مُضافًا إلى موضوعات العالَم، ويحيل عندئذٍ إلى نفسه، لا إلى عناصر العالَم الخارجية.
ثالثًا: الإبداع بما هو قيمة جمالية: عهدنا قبل الفن الحديث على فهم الجمال بما هو أعقد من مجرد التجديد؛ فمن الممكن أن يكون العمل جميلًا دون كثير من التجديد، كما قد يكون منخفض القيمة الجمالية في الوقت الذي يصل فيه إلى حد بعيد من الابتكار. أما في الفن الحديث فقد صار للجديد قيمة جمالية مستقلة. السبب الرئيس وراء ذلك كله، أيْ فلسفة الفن الحديث نفسها، أنَّ الرومانسية من جهة قد وصلت في الفنون المختلفة إلى أقصى مدى يتصوره المبدعون في المعالجة الذاتية للموضوعات الواقعية، ولم يعد مِن بدٍّ سوى الإقلاع عن إدمان الواقع، ومن جهة ثانية صار الفنان أميل إلى الشكّ في المثل العليا الجمالية، والفنية، ومن جهة ثالثة تزامنت نشأة الفن الحديث مع ازدهار الواقعية، التي اشتملت على بعض التوجهات المتطرفة، كالواقعية الاشتراكية.
يستدعي التطرف تلقائيًا التطرف المضاد؛ فإذا ظهر مَن يزعم أن علينا أن نقدم الموضوع كما هو في الواقع، بالدرجة القصوى الممكنة من الأمانة التسجيلية، فسيكون من المتوقع أن ينهض من يطالب بأن علينا؛ كي نكون فنانين أُصَلاء، أنْ نخترع واقعًا بديلًا. إذًا فإن الهدف من الفن الحديث ليس مجرد إثبات الذات في مقابل الحكايات الكبرى للآباء، بل أن يتحول الفنان من المحاكاة إلى الخَلْق. باختصار: إذا كان الفنان التقليدي يرسم مشهد الحديقة مثلًا، فإن الفنان الحديث يخلق حديقة أُخرَى.
من أشد نزعات الفن الحديث تطرفًا هي نزعات ضد-الفن، وهي التي تذهب إلى حد إعادة تعريف الفن على نحو جذري؛ وكنا قد كتبنا على موقع معازف منذ سنوات دراسة بعنوان الموسيقى السالبة بما هي إحدى نزعات ضد-الفن، هي ضد-الموسيقى، وعنينا بها الموسيقى، التي تجعلنا نتساءل عن معنى الموسيقى بالاعتماد على أحداث غير موسيقية، كمشهد أوركسترا، يجلس عازفوه دون فعل شيء، أو إصدار صوت. كما قدمنا عدة أمثلة عليها، مثل جون كيدج، وشولهوف، ويفيز كلاين.
في هذه المقالة نقدم نزعة أخرى من نزعات ضد-الموسيقى، المعروفة باسم موسيقى المحيط، فننتقل بذلك من موسيقى الصمت، الذي يسمح لنا بإدراك الضوضاء الخلفية، إلى موسيقى الضوضاء، التي تستحضر هذه الخلفية بشكل مباشر.
بينما تضعنا الموسيقى السالبة عمليًا في موضع التساؤل عن مفهومنا عن الموسيقى من خلال عازف صامت، أو صوت مُبَرِّد (ثلّاجة)، فإن موسيقى الضوضاء تضعنا هذا الموضع على نحو مختلف من زاويتين: الأولى أننا لا نتساءل فيها عن معنى الموسيقى بالدرجة الأولى، بل عن إدراكنا للموسيقى، فهل الموسيقى موجودة، ونحن الذين ندركها على نحو سلبي، أم أننا نحن من يتمتع بغريزة استبصار النظام في الفوضى بطبيعة عقولنا، فنجد الموسيقى في ما ليس كذلك؟
الزاوية الثانية هي زاوية مادة المعالجة؛ فبدلًا من العازف الصامت، أو صوت السيارة مثلًا، نجد في موسيقى الضوضاء مزيجًا من أصوات الآلات الموسيقية، والأصوات غير الموسيقية، ودرجة عالية الحساسية بين النظام والفوضى. في رأينا تبلغ تلك الدرجة سابقة الذكر بين النظام والفوضى أقصى مدى ممكن لها، أي تقترب بالدرجة القصوى من الحد الفاصل بالضبط بين كل منهما، في موسيقى المحيط. هذا من أهم أسباب اهتمامنا بها، وتخصيص مقالة عنها.
نظرًا لأنّ قارئ مقالاتنا، بالذات على معازف، غالبًا ما سيكون على دراية أو ذا اهتمام بالموسيقى الكلاسيكية فقد يتساءل: وما الجديد؟ لقد قدم ديمتري شوستاكوفيتش مثلًا موسيقى الآلة Clockwork، أيْ أنه استعمل الأوركسترا ليُنتج أصواتًا أقرب إلى الآلات الميكانيكية الدائرة، وهذا يكسر مفهومنا التقليدي عن الموسيقى، كما قدم الحداثيون عمومًا، بما يتضمن شوستاكوفيتش، درجةً بين النظام والفوضى. بل إن بيتهوفن، أحد أعمدة الرومانسية، قد قدم في سيمفونيته التاسعة، في الحركة الرابعة، استعراضًا لألحان الحركات الثلاث السابقة، وهو نوع من كسر الحائط الرابع، يدفعنا للتساؤل عن مفهوم العمل الموسيقيّ.
الجديد هو أن كل هؤلاء قد اعتمدوا على آلات الأوركسترا. حتى إذا كان بعضهم قد اعتمد على آلات غير معهودة في الأوركسترا فهي آلات موسيقية أولًا وأخيرًا. أما في موسيقى الضوضاء فهناك أهمية للأصوات المحيطة، التلقائية، كالتي تسمعها في الشارع، أو المكتب، أو محطة القطار، لا تقل أهميتها عن أهمية آلات الأوركسترا. من ناحية أخرى الهدف والسياق مختلفان؛ فلم يكن قصد شوستاكوفيتش في المقام الأول وَضْع الموسيقَى موضع سؤال، بل بيان ما اعترى الإنسان، والمجتمع من تبدّل كبير مع تسارع الأحداث التاريخية، والتحولات الكبرى المفاجئة في عصر الصناعة، بدءًا من الثورة الفرنسية، وحتى الحرب الباردة.
ربما يمكننا بهذا المنطق أن نتنبأ بالموجة القادمة في الموسيقى، وفي الفن عمومًا، إذا كانت أغلب التوقعات تؤيد الاعتقاد بأننا حاليًا على مشارف ثورة جديدة، مختلفة، وعلى قدر ربما يكون أشد من الراديكالية، هي ثورة الذكاء الاصطناعي.
كيف تَصنع الضوضاءَ؟
ما الضوضاء؟ وهل يجب أن نقدم تعريفًا للموسيقى أولًا؛ كي نميز الضوضاء بالضد؟ بعبارة أخرى: هل الضوضاء هي ضد الموسيقى؟ للأسف لا يمكن الإجابة عن سؤال ماهية الضوضاء كأننا نرسم خطًا مستقيمًا بين نقطتين؛ فأول الصعوبات هي أن تعريف الموسيقى نفسه إشكالي، ويفتح بابًا جانبيًا لجدل قد لا ينتهي.
مما يزيد هذا الإشكال تعقيدًا في السياق الحالي هو أن موسيقى الضوضاء، وبما هي نزعة من نزعات ضد-الفن، من أهدافها الأساسية أصلًا إعادة طرح السؤال عن ماهية الموسيقى. ثاني الصعوبات هي أن بعض الأنماط الصوتية لا هي موسيقى، ولا هي ضوضاء، كدقات الساعة مثلًا، التي لا نصفها بكونها موسيقى، لكنها كذلك ليست ضوضاء. رنين الهاتف مثلًا، الرنين التقليدي القديم للهواتف التقليدية، ليس موسيقى، لكنه، إنْ كانت له أهمية ما، ليس ضوضاء.
في الواقع فإن المثال الأخير من مفاتيح الحل، لكن دعونا نوضح أولًا كيف نفكر في هذه المسألة، وبأي منهج. نظرًا لأننا لا نريد التوقف عند حدود الاعتقادات المسبقة، التي ستكون مُقامَة على أسس نظرية، لا نزعم الاعتقاد فيها، أو لا نملك مساحة للبرهنة عليها في هذا المقام الضيق، فإننا سنطبق المنهج الظاهراتي.
ببساطة تناسب غير المختص يمكن شرح هذا المنهج بأننا سنحاول الوقوف على التعريفات المطلوبة في وعينا نفسه: ما نقول عنه في العادة ضوضاء، وما لا نقول. هو منهج معروف منذ مائة عام تقريبًا في الفلسفة، واشتُهر به هُوسَرْل، وهَيْدِجَر، وفلاسفة الوجودية، ويتميز بكونه قادرًا على استخلاص المعاني من الأذهان دون فرضيات مسبقة غير نقدية، وبالتالي وضْعها موضع الدراسة كأنما هي وقائع غير ذاتية.
من المفيد دائمًا في مثل هذه الحالات أن نوسع من دائرة استعمال اللفظ؛ فنحن نطلق مجازًا على الخليط الضوئي – وإن كان هذا يتم في التداول اللغوي الغربي أكثر من العربي – ضوضاء ضوئية، مثلما نصف الأشكال على شاشة التلفاز مثلًا بعد انقطاع الإرسال بالضوضاء البيضاء. أيضًا، قد يصف أحدهم قصيدة غامضة مزدحمة التفاصيل بأنها تشتمل على ضوضاء من المعاني. كما قد يقول آخَر عن منطقة لا تتمتع بناياتها بنمط واحد، أو حتى بعدة أنماط من بيئة واحدة، بكونها ضوضاء من الأشكال.
هنا نستطيع استخراج عدة خصائص أساسية للضوضاء: فأولًا: هي مجال من المحسوسات (الأصوات والمرئيات خصوصًا)، أو من المعقولات (المعاني)، وثانيًا: هي مجال مزدحم بالتفاصيل، ومعقَّد، وثالثًا: هناك تداخُل، وعدم تَناسُبٍ بين تفاصيل هذا الازدحام، ويمكن التعبير عن ذلك أيضًا بالافتقار إلى بنية يمكن تتبعها، وعدم توافر إيقاع، ورابعًا: هناك صفة سلبية بشكل أو بآخَر في الاستعمال التقليدي للفظ ضوضاء. مثلًا تلك القصيدة الغامضة، إذا وصفناها بأنها ضوضاء من المعاني، ثم اكتفينا بهذا، لكان هذا وصفًا سلبيًا، يعني أن الشاعر قد اختلطت عليه الدلالات، أو أنه غير متمكن من وسائطه التعبيرية.
قلنا أعلاه إن من مفاتيح الحل مثال رنين الهاتف التقليدي، الذي لا نعتبره موسيقَى، لكننا لا نعتبره كذلك ضوضاء، إذا لم تكن له أهمية لدينا. فإذا كنتَ جالسًا لتقوم بعملك في حجرة تتضمن عدة مكاتب، وتصادف أن أصدر أحد الهواتف على مكتبٍ مجاوِر رنينًا، بحيث لا تخصك هذه المكالمة، فإنه مجرد ضوضاء، تشتت تركيزك. لكن إن كانت هذه المكالمة تخصك، أي إذا كان الهاتف على مكتبك بالذات، أو أنك تنتظر هذه المكالمة بالذات، فلن تعتبر الرنين ضوضاء، ولن تعتبره موسيقى، بل ستعتبره تنبيهًا، ستعتبره صوتًا له وظيفه محددة غير فنية، وغير جمالية.
هنا تنكشف خاصية جديدة هامة للضوضاء، هي أنها عديمة الوظيفة. هي صفة نسبية بطبيعة الحال؛ فقد يكون لما تطلِق عليه لفظ الضوضاء وظيفة بالنسبة لغيرك، وعندها لن يصير ضوضاء بالنسبة له. مع ذلك فإننا لا نعتبر أصوات الطبيعة المختلطة، كما نسمعها في غابة، ضوضاء، حتى إذا تضمنتْ كل الخصائص السابقة. والسبب في هذا هو أننا لا نفترض أصلًا بالطبيعة أن تكون لأصواتها بنية، أو إيقاع، أو وظيفة معينة.
يكشف هذا عن خاصية مضافة إلى الخواص السابقة، هي أن الضوضاء عادة ما تُنسَب إلى المصنوعات، لا المطبوعات. الضوضاء، كالموسيقى، صنعة إنسانية من حيث التعريف. يمكن بالطبع أن نطلق أحيانًا على أصوات الطبيعة المتداخلة في غابة، أو حديقة، أو على شاطئ يخلو من الناس، لفظَ الموسيقى، لكنه سيكون تعبيرًا مجازيًا، ونَعرف أنه مجازيّ. السبب في أن الضوضاء مصنوع إنساني هو أننا نفترض في ما يصنعه الإنسان أن يكون له هدف، وأن يخدم غاية معينة، وإلا لَمَا بذل جهدًا فيه، في حين أننا لا نفترض ذلك في الطبيعة، أو أننا نفترض أن لكل شيء في الطبيعة هدفًا، حتى وإنْ لم ندركه بعدُ.
يمكننا عند هذه النقطة، بعد أن استطعنا استنباط خصائص محددة للضوضاء، أنْ نميز بين الموسيقى والضوضاء على النحو التالي. فبرغم أن كلًا منهما إضافة إنسانية إلى الطبيعة، وأنهما مجال من الأصوات، فإنهما تختلفان في كل الخواص السابقة الأخرى: فالموسيقى تتمتع ببنية، ونظام معين، يمكن من حيث المبدأ تتبعه؛ والموسيقى ذات وظيفة، وغاية، ليس بالضرورة بمعنَى ما نفهمه منها، وما يمكننا صياغته في عبارة باللغة الحقيقية، أيْ بالمعنى الحقيقي للغة، بل بمعنى حبكة فنية معينة، وغرض جمالي. كما تتمتع الموسيقى بتناسق معين، قد لا ندركه للوهلة الأولى، غير أننا ندرك أننا قادرين على فهمه مع المران الذَّوْقي.
حين نصف نظامًا ما من الأصوات بأنه موسيقى، فهي صفة حسنة؛ ذلك أننا إذا وصفنا مجموع الأصوات المختلطة في الغابة، أو الحديقة، بلفظ الموسيقى مجازًا، فإن هذا يحمل عادة قيمة إيجابية؛ ورغم أن فلاسفة الموسيقى ونقادها قد اختلفوا منذ فجر الفلسفة الإغريقية في ماهية الموسيقى، فربما يمكن الاكتفاء في هذا المقام بتلك الخواص العامة، التي لا يختلفون فيها غالبًا.
لكاتب هذه السطور بحث مسهب في هذا الموضوع، ينتهي إلى أن جوهر الموسيقى هو أنها صيرورة صوتية شبه منتظمة، ومحسوسة. بيد أننا لا نحتاج العودة إلى مثل هذا البحث في المقام الحالي إلا على سبيل التوسع في هذه النقطة بعينها الصياد، كريم: أُنطولوجيا الموسيقَى، دراسة في الموسيقى بما هي كائن، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الآداب، جامعة القاهرة، ٢٠٢٢. وقد نُشر على معازف مقالٌ مطول يلخص أهم مسائل البحث تحت عنوان: اكتشاف كائن الموسيقى..
على كل حال هذه النتيجة الأخيرة هي العلة، الذي دعتْنا لأنْ نطلق على هذا النوع من الموسيقى، وعلى المقالة ككل موسيقى الضوضاء، لا موسيقى المحيط، كما أطلق عليها أصحابها. كما قلنا، يحمل لفظ الضوضاء دلالة سلبية، قد تثير السخرية في سياق التنافس بين الفنانين والنقاد. ربما كان هذا هو السبب في أن مؤسسوها قد استعملوا لفظ المحيط في أسماء بعض أشهر ألبوماتها. وصف دقيق كذلك في رأينا، إذا كنّا بصدد اختيار أفضل عنوان ممكن لألبوم. بيد أننا – في هذه المقالة فقط – نستعمل لفظ الضوضاء للإشارة إلى طول المسافة، التي يقطعها المؤلف من الضوضاء إلى الموسيقى، إذا اعتبرنا الضوضاء نقيضًا للموسيقى. كما أن مؤلفِي هذه الموسيقى لا يستهدفون بأعمالهم تقديم مجرد أصوات البيئة المحيطة، بل يَتغيَّوْن بالأحرى دفعنا – لا شعوريًا – إلى إيجاد نظام في الفوضى، موسيقى في لا-موسيقى؛ واللا-موسيقى حقًا هي الضوضاء حقًا.
يجب أن نميز أمام القارئ أيضًا بين استعمالنا لتعبير موسيقى الضوضاء في هذه المقالة، وبين مصطلح موسيقى الضوضاء اليابانية، التي تُنسَب إلى فنانين مثل مرزبو، بالإضافة إلى توظيف الضوضاء في الموسيقى الصناعية (إندستريال) لدى ثروبينج جريسل أو آرت أف نويز أو وايتهاوس ومن قبلهم روسولو، والحركة المستقبلية الإيطالية.
تاريخ الضوضاء
أشرنا في مقالات سابقة على معازف، مثل تسليح الموسيقى الكلاسيكية، إلى أن الموسيقى الكلاسيكية قد انتهتْ تقريبًا في السبعينيات، مع وفاة اثنين من أهم أعلام الموسيقى الكلاسيكية المعاصرة هما سترافنسكي وشوستاكوفيتش؛ بسبب تفكك البنية، وهي التي قامت على صيغ محددة، كصيغ الصوناتا، والروندو، والرقصة … إلخ.
لأسباب يطول ذكرها، فضلًا عن شرحها، كان مسار الفن في الغرب يتجه تدريجيًا نحو تحلل الصيغة، والشكل. من أهم مظاهر ذلك ما ذكرناه في التقديم من أمر التجريب، الذي أصبح مرادفًا للإبداع.
حاول بعض المؤلفين استعادة الصيغة، لكن نُظِر إلى ذلك كمحاولات فردية؛ فقد انهار سلطان الصيغة، والشكل، ولم يمكن استعادته قطّ. يمكن لمؤلف ما اليوم بطبيعة الحال أن يؤلف سيمفونية، أو كونشرتو، في صيغ معينة محددة، لكن هذا في حد ذاته سوف لن يزيد عن مجرد تجربة من التجارب الكثيرة المنتشرة في الفن حاليًا.
حين قدم بيتهوفن مثلًا سيمفونيته التاسعة مستعملًا في حركتها الرابعة الصوت البشري، نُظِر إلى ذلك في عصره، في الربع الأول من القرن التاسع عشر، كتجديد، وكتحدٍّ للسائد، لكنه إذا قدم ذلك اليوم، فسوف نتساءل: تجديد بالنسبة إلى ماذا؟ وتحدٍّ لماذا أو لمن؟
في اعتقادنا أن الأصل، الذي تفرعت منه موسيقى المحيط – ضمن فروع عديدة سواها – هو ما بعد الرومانسية، أول حركة فنية في حدود علمنا تحاول استكشاف معنًى مختلف شامل للفن، وبديلًا جذريًا للعلاقة المعقودة منذ مئات السنين على الأقل بينه وبين الواقع، من خلال مفهوم الفن كواقع افتراضي، وذلك بعد أن استنفدت الرومانسية المتأخرة تقريبًا – خاصة مع فاجنر – كل إمكانات التعبير، التي تمتعت بها الموسيقى التقليدية، التي يظل لها شكلٌ شبه ثابت من جهة، وتظل موسيقى من جهة أخرى.
بهذا لم يعد أمام المبدعين؛ لكي يجدوا طريقهم الخاص الأصيل، إلا أنْ يَتحدَّوْا فكرةَ الطريق نفسها. كانت هذه المحاولة ناجحة، حتى لتضاهِي درجة نجاح الرومانسية في تغيير وجه خارطة الفن إلى الأبد، وعلى نطاق لم ير التاريخ مثله من قبل؛ بسبب انتشار وسائل الاتصال في القرن التاسع عشر، وأهمها الصحافة.
كان التطور التقني يسير في صالح الرومانسية، ينشر دعواها إلى آفاقٍ لم يتخيلها مؤسسوها، فاستمر كذلك صداها يتردد في الجغرافيا، بعد أن انقطع من التاريخ، حتى عرفناها مدرسة كبرى في الشعر العربي الحديث من حيث تنوع المدارس الفرعية، وانتشارها، وقوة أثرها في الجيل التالي. لكن التقانة خذلتْ الرومانسية بعد اختراع آلات التصوير، والسينما، والموسيقى الإلكترونية، حين بدأت الابتكارات التقنية تصب مباشرة في صالح ما بعد الرومانسية، وما تفرع منها من مدارس كثيرة، منتشرة، لم تُكتب لبعضها نهاية بعدُ.
لقد ساهمت التقانة في نشر أفكار الرومانسية، وأعمالها، لكنها دخلت هي نفسها مكونًا من مكونات نزعات ما بعد الرومانسية؛ حيث أهّلت المبدعين لتصوير الواقع على نحو بديلٍ، لا يتماهى معه إلا بقدْر ما يختلف عنه. إن دور التطور التقني في صناعة الآلات الموسيقية الإلكترونية لَحاسمٌ في ظهور موسيقى المحيط أصلًا؛ ذلك أنَّ المؤلف يسعى – من حيث التعريف – لإنشاء محيط، مجال عريض منهمر من أصوات الآلات، وأصوات البشر، والنغمات، والطبقات، بحيث ينقل لك خبرة سمعية كاملة، لا مجرد عمل موسيقي واضح البنية واللحن.
لا يستطيع المرء من دون الموسيقى الإلكترونية إنتاج كل ذلك على نحو متكافئ، وبسرعة في الإنتاج، تَضمن تواصل الأفكار في العمل، وبقدْرٍ يسمح بمشروع موسيقي، لا تجربة عابرة فحسب.
لْنلاحظ كذلك أن موسيقى المحيط إحدى نزعات ضد-الفن، وبالتالي فهي تقف موقف النقيض المباشر، ليس مِن الرومانسية، ولا مما بعدها، بل مِن المدارس التي تتوسط تاريخيًا، وأسلوبيًا، المسافة بين ما بعد الرومانسية، وبينها هي؛ وخصوصًا التأثيرية والتعبيرية والسريالية، والكلاسيكية الجديدة؛ لأن تلك المدارس الأخيرة طرحت كلها السؤال نفسه: “هل هناك واقع، إذا كنّا قادرين على اصطناع خداع الإدراك في الفن؟” إذًا فكيف نضمن أننا لسنا طيلة الوقت مخدوعينَ ببيانات حسية بلا عدد محدد، وبلا علاقة محددة بالوجود الفعلي؟ من هنا مفهوم الفن كواقع افتراضي، كعالَمَين تربطهما علاقة مشابهة سطحية في الظاهر، وعلاقة اختلاف بالغ في المادة، والصورة.
من ثمَّ جاء سؤال موسيقى المحيط الجوهري: “هل هناك فن، إذا كنا قد فقدنا التمييز بين الفن والواقع؟” لهذا فموسيقى المحيط تيار، يشمل عدة مدارس، لكن لكل منها الهدف نفسه: العثور على الفن والواقع معًا، بعد إنكارهما معًا. إنها رحلة بحث عبر نسيج هائل التنوع لسفينة صغيرة منقوشة على ذات النسيج هائل التنوع. علينا، كي نميز بين الواقع والخيال، أنْ نتخيل كلَّ ما يمكن أنْ يصير واقعًا، وأن نفهم مدى محدودية المساحة، التي تمثل كل مدى حركتنا صعودًا وهبوطًا على درجات الطيف، مقارنةً بما عليه الحال في عوالم أخرى ممكنة، لكنْ لم تُواتِها الصُّدفةُ، أو تؤازرها قوانين الاحتمالات؛ لكي تتحقق.
لذلك ليس من قبيل المصادفة أن يظهر مفهوم موسيقى المحيط بمعنًى محدد في أواخر السبعينيات. عادةً ما يؤرَّخ لظهوره بعمل الإنجليزي بريان إينو (١٩٤٨-؟) موسيقى المحيط-١: موسيقى للمطارات الصادر عام ١٩٧٨. والعلة وراء بدء التأريخ التقليدي لهذه الموسيقى بهذا الألبوم هي استعماله الصريح لتعبير موسيقى المحيط، وقيامه بما يشبه التنظير لهذا النوع من الموسيقى. فهي – بحسبه – موسيقى توحِي لكَ بأنكَ قادر على أنْ تتجاهلها. موسيقى تتحرر من القولبة المسبقة للموسيقى في هيئة أعمال واضحة البنية، لا يتطرق الشكُّ إلى صيغتها، أو إيقاعها، أو لحنها. هي تركز بدلًا من الإيقاع، واللحن، على الجوّ العام والبيئة المحيطة، وانطباعنا العام عن الأصوات الجارية في الخلفية.
الهدف من تحرير الأصوات من تلك القولبة الجاهزة هو فتح المجال للعقل لكي يتأمل، ويعيد تركيب المسموعات في بنية يتصورها، ويستكشف أبعادًا لم يتصورها لنسيج الصوت الغامِر، الثريّ، الملوَّن، الباذخ. بمناسبة ذكر بريان إينو فهو أحد الفنانين تأثرًا بالأعمال الأولى لستيف رايش، وأحد روافد جون كيدج، الذي تعرضنا له في التقديم في معرض المقارنة العامة بين موسيقى الضوضاء من جهة، والموسيقى السالبة؛ وقد أشرنا في دراسة الموسيقى السالبة إلى اعتماد هذا النوع من الموسيقى على إبراز أصوات الخلفية المهيمنة على صمت العازفين، ذلك الصمت، الذي يسمح بالتركيز في المقابل على أصوات المحيط.
على أن مثل هذه الخصائص العامة لموسيقى المحيط قد بدأت مع تجارب الموسيقار الفرنسي المعروف إريك ساتي (ت ١٩٢٥)، وهو يصنف عادة كبَعد-رومانسي، وأحد آباء جيل من الموسيقيين الانطباعيين كموريس رافل، وكلود ديبوسي. الثلاثة معروفون لمستمعي الموسيقى الكلاسيكية على أية حال. لهذا قد يذهب القارئ إلى القول بأن موسيقى الضوضاء قد نشأت كفرع من الموسيقى الكلاسيكية. غير أن هذا الظن لا يمكن أن يكون دقيقًا؛ فما يميز الموسيقى الكلاسيكية، سوى صيغها المعروفة، هو طبيعتها اللحنية الاشتقاقية.
طالما نحن في معرض الحديث عن تاريخ موسيقى الضوضاء، أو المحيط، فمن الحريّ بنا أنْ نتتبع جذورَها في أعمال أعمدة أخرى في مرحلة ما بعد الرومانسية في الموسيقى. من أهم الأعلام في تلك المرحلة سيرجي رحمانينوف، ويان سيبيليوس، اللذين تعرضنا لهما في عدة مقالات على معازف.
من الجائز في ظننا أن نجد بعض خواص موسيقى الضوضاء في سيمفونيات سيبيليوس، التي يتبلور اللحن فيها مِن سحابة رعدية خَلْفية، تعزَف عادة بالطبول والنحاسيات والوتريات منخفضة الطبقة. أما في حالة رحمانينوف فمن الواضح أن بنيته قد تمتعت، خاصة في أعماله الناضجة كالسيمفونية الثانية، وكونشرتو البيانو والأوركسترا رقم ٣، بدرجة من التذبذب في البنية بين التفكك، والتماسك، بل صارت حبكة العمل ككل هي ذلك الصراع بينهما؛ وهو ما يمكن اعتباره هيكلاً خشنًا بالنسبة للجسد الكامل الثري الدقيق في التفاصيل، الذي تتمتع به موسيقى المحيط.
أما من جهة استعمال النغمات، والألحان، فمن المؤكد حضور اللحن في تلك الأعمال لسيبيليوس، ورحمانينوف في موضع مركزي من البنية العامة للحركة. بيد أننا مع الوقت نلاحظ أن تلك المركزية قد بدأت تتزحزح، كلما توالت الأجيال، حتى وصلنا مع موسيقى المحيط إلى المحيط بالاصطلاح الهندسي، محيط ليس له مركز، أو له عدد من المراكز معًا. ما يميز منظور موسيقى المحيط هو أنها قادرة على الإلمام بالكتلة الكونية الجسيمة، وقادرة على فهم المدى، الذي يمكن أن تبلغه الكائنات. إنها أقدر من غيرها على اختبار الحدود القصوى لإدراكنا للنظام بما هو نظام، وللفوضى بما هي فوضى، بأعدل التجارب.
هكذا ظلت فكرة موسيقى المحيط تتبلور، وتوظف لها كل الإمكانات المتاحة عبر عقود من التطور التقني السريع، لتصل منذ تجارب إريك ساتي المبكرة، إلى قفزة نوعية مع مدرسة، جمعت بين الاهتمام بكل من الموسيقى الإلكترونية، وموسيقى المحيط في الأربعينيات من القرن الماضي، هي مدرسة الموسيقَى المجسَّمة، أو المادة الخام للموسيقى، التي اشتهر بتأسيسها اسمان هما الفرنسيان بيير شيفر، وبيير هنري Stefan Baranowski, Insight Focus: An Introduction to Ambient Music, August 25, 2023, p. 3..
كما يمكن إسناد دور تأسيسي في هذه المدرسة أيضًا للموسيقار المصري-الأمريكي حليم عبد المسيح الضبع (ت ٢٠١٧) Holmes, Thom, Electronic and Experimental Music: Technology, Music, and Culture, Routledge, pp. 156-157.. تنحو هذه المدرسة في التأليف نحوًا معكوسًا؛ فيقوم المؤلف بتسجيل محيط كامل، غني، من الأصوات في مكانٍ ضوضائيّ، ومن ثم يجري مئات التعديلات على هذا المزيج الصوتي الخام، بكل الوسائل المتاحة مِن تغيير الزمن، والطبقة والنغمة، والحذف والنسخ، لينحت منه، ويلون فيه، ما يصنع من هذه الهيولَى أشكالًا محددة من الأنماط الديناميكية المتكررة في مسار نغمي مغلَق (لووب).
أعتقد أننا يمكن أن نرى في هذه التقنية كيف هو النحت الموسيقيّ، نحتٌ لجنينِ موسيقى ناعسٍ في رحم الضوضاء، التي التحم باطن رحمها بالجنين عبر أطياف حساسة من الشفافية إلى العتمة مرورًا بكل درجات اللون، اتحد بجسمها، فلا يُولَد أبدًا. إذا كانت الموسيقى التقليدية تُؤَلَّف من أجزاء بسيطة أساسية على مستويات متفاوتة في درجات التعقيد، فإن موسيقى المحيط لا تُركَّب من أجزاء أبسط، ليست كُلًّا يتكون من أجزاء، بل هي جزء يتمايز تطوريًا عن نسيج الكل.
هكذا اجتمعت كل الشروط الضرورية لظهور مفهوم موسيقى المحيط أخيرًا، انتقالًا من الوسيلة إلى الغاية؛ الوسيلة هي المادة الخام، الضوضاء كمادة خام، والغاية هي الإيحاء بنظام باطني، يتحرك مركزه عبر أبعاد عديدة، ولا تراه كاملًا في لحظة واحدة مطلقًا.
في عام ١٩٦٢ أسس كل من رامون سنْدَر ومورتون سَبُوتنِك مركز سان فرانسسكو لموسيقى الشرائط، حيث تعاونا مع عدد من الموسيقيين من أصحاب التجارب الجديدة في إنتاج موسيقى تستغل ما أتاحته إمكانية تسجيل الأصوات مِن القص واللصق، وتسجيل صوت على خلفية على الشريط نفسه، وصدى الصوت، والمسارات المغلقة (لووبات)، وإدارة الصوت بالعكس، وغيرها.
في حقبة السبعينيات بدأ الاعتماد على أجهزة الكمبيوتر، والخوارزميات الحاسوبية، في التأليف، خاصة بأعمال رائدة هذا التطوير الأمريكية لوري سبيجل (١٩٤٥-؟). اشتهرت سبيجل بأعمال ذات رؤية صوتية كونية، مثل أول أعمالها الشهيرة الكون المتمدد، وهي استعارة من الفيزياء الفلكية، التي توصلتْ إلى حقيقة أن كوننا يتمدد باستمرار، وبمعدل متسارِع، وتآلُف العالَم، وهو عنوان للفلكي المعروف يوهانيس كبلر في القرن السابع عشر، يصف فيه قوانين حركة الأفلاك، والجاذبية المستحَثَّة Enhanced Gravity، وغيرها. سنجد في موسيقى المحيط بصفة عامة، كما سنرى في أمثلة تالية، إلى أي مدى صارت موضوعات الخيال العلمي مجالًا أساسيًا للمعالجة الموسيقية.
في هذه الحقبة كما أسلفنا – السبعينيات – ظهر تعبير موسيقى المحيط بصورة مباشرة، ليعبر عن المشترك بين كل هذه التجارب، والمدارس على يد بريان إينو، الذي سلف الحديث عنه. تفرعت عدة مدارس من موسيقى المحيط بعد إينو، مثل الهاوس المحيط في الثمانينيات، وموسيقى المحيط الإلكترونية في التسعينيات، والمحيط المظلم في العقد الأول من الألفية الثالثة.
هذا الملخص السريع لتاريخ موسيقى المحيط منذ الإرهاصات لا يفي بالطبع بكافة التفاصيل؛ فعلى خلاف مدارس الموسيقى الكلاسيكية مثلًا تتفرع مدارس الموسيقى الحديثة على نحو غزير حقًا في صورة فروع، وفروع للفروع، وهكذا في شكل شَجَري. غير أن ذلك التلخيص يمنحنا سياقًا، نتمكن من خلاله مِن إدراك معدل التطور، ومحطاته الأساسية، وعوامله.
السبب في ذلك التفرُّع البالغ لاتجاهات موسيقى المحيط فيما نعتقد ينقسم إلى عاملين، هما الأكثر أهمية: عامل التجديد بما هو إبداع، الذي منح للابتكار في حد ذاته قيمة جمالية، مما جعل من كل تجربة أساسًا صالحًا لمدرسة، أو اتجاه. كانت الحال خلاف ذلك في الموسيقى الكلاسيكية؛ حيث كان على المؤلف أن يمضي عقودًا لبلورة مدرسة جديدة، بمعدل أبطأ، وبجهد أكبر، واحتمالات أكثر للفشل. أما العامل الثاني فهو التطور التقني، الذي أشرنا إلى كونه عاملًا حاسمًا في تطوير موسيقى المحيط، وهو تطور لم ينقطع إلى الآن، وربما زاد معدله مع تطوير الذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب جدًا.
موسيقى للمَطارات
قبل المزيد من التعمق في مفهوم موسيقى المحيط ربما وجب التوقف عند نماذج منها؛ وذلك كي يجد القارئ مجالًا لتطبيق تلك الخصائص، التي سنتعرض لها لاحقًا. سنتوقف عند نموذجين هما بريان إينو، باعتباره صاحب التأسيس المفهومي، ودنيس هدلستون الذي نعتقد أنه قدم أغلب خصائص موسيقى المحيط في جل أعماله، كما أنه يوضح لنا إلى أي حد تطورت موسيقى المحيط منذ التأسيس في أواخر السبعينيات وحتى اليوم.
سبق وأن أشرنا إلى عمل إينو موسيقى المحيط-١: موسيقى للمطارات كأول عمل يحمل صراحة اسم موسيقى المحيط. هو عمل بسيط التكوين، يتكون من أربعة أجزاء/حركات، ويستغرق ٤٨ دقيقة و٤٠ ثانية. وضعه المؤلف لينقل الجوّ المترقب، المزدحم بالأصوات، الذي يمكننا ملاحظته في صالات المطارات، ومِن ثَم العنوان. سنشير فيما يلي إلى الأصوات، التي تُنتجها وسائط الموسيقى الإلكترونية بما يعادلها من أسماء الآلات الحقيقية، وذلك لتيسير عملية تمييزها.
تبدأ الحركة الأولى بلحن هادئ، مسالم، بصوت البيانو، ويعزَف على طبقتين، منخفضة، ومتوسطة. بعد ذلك يبدأ احتشاد تدريجي لمجموع من الآلات، كجنين يكسوه اللحم طبقة فوق طبقة، لكنْ يظل البيانو هو الهيكل العظمي، الذي ينظم الجسد الكامل. ما يوضح لنا منذ مطلع العمل إحدى تقنيات موسيقى المحيط، وهي (التسجيل فوق التسجيل)، الطريقة التي اتبعها إينو في تركيب هذا العمل. كما يبين لنا ذلك تصور المؤلف لبناء عمله؛ فهو لا يتطور كحركة سيمفونية تقليدية، كما يمكن أن نجد في أعمال شوبرت، أو شومان مثلًا، التي تُشتَقّ فيها الجمل الموسيقية اللاحقة من السابقة. على خلاف البناء الكلاسيكي الاشتقاقي يعتمد هذا العمل، وهي من أساسيات بناء موسيقى المحيط عمومًا، على المسارات اللحنية المغلقة، التي يجري تدويرها باستمرار، مع حشد المزيد من الأصوات / الآلات لكسر الرتابة.
بعد أن يفهم المستمع مسار تطور الموسيقى، تبدأ طرقات البيانو في التأكُّد، ويشتدّ الهيكل بالتالي. وبداية من الدقيقة السابعة يبدأ المحيط في التجسُّم بدرجة أكثر ثراءً، ثم نستمع إلى أصوات الفلوت والكلارينيت، وهي تعزف نغمة واحدة ممتدة. هنا يستغلّ إينو الخداع الصوتي، حيث ينخدع المخّ بتداخل الأصوات، ليصنع ما يشبه نبضات. كما يلعب تداخل الموجات دورًا في صياغة هذه النبضات بسبب ما يعرف في الفيزياء الموجية بالتداخل البنّاء، والتداخل الهدّام.
إذا تزامَنَ قاع الموجة الأولى مع قمة الموجة الثانية، اختفى الصوت، وإذا التقى قاع بقاع، أو تزامنت قمة مع قمة، تأكّدَ الصوت. من الهامّ أن يلاحظ المستمع/القارئ كيف يسمح اللوب اللحني المعزوف بصوت البيانو بتجاهله، وعلة ذلك هي تكيف المخّ مع الصوت المتكرر، وما هو مستمر، أو متكرر من المحسوسات بصفة عامة أقل في إثارة الانتباه، حتى قد لا ننتبه إليه كليةً بعد هنيهة، كدقات الساعة مثلًا.
تبدأ الحركة الثانية بأصوات بشرية، على عدة طبقات متوسطة، وتغني لحنًا مشتقًا من لحن الحركة السابقة، ثم تتتابع أصوات الوتريات، لتصحب الأصوات البشرية. حركة أقل ترحيبًا من الحركة الأولى، وذات جوّ مقبِض، لكنه غير مخيف، وغير حزين. ربما يمكن القول إنه محايد حياد الآلة تجاه الإنسان. تستمر معنا الأصوات البشرية في الحركة الثالثة، لكنها مصحوبة بصوت البيانو هذه المرة، بينما يبرز دور أصوات الأرغن والكورنو في الحركة الرابعة.
نجد في العمل بصفة عامة عدة خصائص هامة لموسيقى المحيط، فأولًا استغنى المؤلف عن الإيقاع لصالح اللوب اللحني، الذي يمنح العمل إيقاعًا بشكل ما. ثانيًا – وهي خاصية معروفة للفن الحديث بصفة عامة – ندرك بوضوح كيف أن هذه الموسيقى غير عاطفية، وهو وصف سيجده القارئ بسهولة، إذا طالع تحليلًا لأعمال موسيقى المحيط. ما يوحي بكونها غير إنسانية.
إننا إذا نظرنا إلى لوحات بيكاسو، كمثال معروف على الفن الحديث، فسنقابل الظاهرة نفسها، ظاهرة اللا-أنسنَة، التي تتمثل في عناصر فنية، وأسلوب، هو أقرب إلى نظرة الآلة المحايدة إلى الإنسان. فبرغم أن الإنسان هو المؤلف، وهو الموضوع، وهو المتلقي، فإن النظرة نفسها غير بشرية، وكأننا نصف كائنًا حيًا من ملايين الكائنات الحية.
تعبر هذه اللا-مَرْكَزَة لموقع الإنسان عن رؤية البشرية لنفسها بعد الحرب العالمية الثانية بالذات، التي تميزت بما يعرف بانهيار الحكايات الكبرى، وتفكُّك النماذج الاجتماعية القديمة، والمثل العليا السياسية والخُلُقية المتهاوية بعد دمار شامل.
تحدثنا بقدر أكبر من الاستفاضة في هذه النقطة، وعن علاقتها بالموسيقى، وعن تأسيسها في الفلسفة الألمانية في مقال المشروع التأليفي لشوستاكوفيتش، الذي سبقت له الإشارة. باختصار يناسب هذا المقام رأى الفلاسفة منذ مطلع الخمسينيات أن تطور التقنية، واستغلالها خاصة في الحرب والقمع والمراقبة وتحقيق الربح، قد أوضح لنا إلى أي حد كانت صورتنا عن أنفسنا مزيفة، تلك الصورة، التي ارتسم فيها الكون كله، ووقف الإنسان في مركزها. بدلًا من ذلك حلت محلها صورة أخرى، يقبع الإنسان فيها في موضع الهامش. لقد عبرت الموسيقى الكلاسيكية المتأخرة عن هذه الفكرة، هذه الصورة البديلة، لكن موسيقى المحيط لا تعبر عنها فقط، بل كذلك تنقلها لنا مباشرة عبر مشهَد سمعي، حتى نكاد نراها.
السُّبات: أصوات لِسَفَرِ المسافات الطويلة في الفضاء
عمل ملحمي، صدر في يناير ٢٠٢٠، ويمثل أحد أحدث الإبداعات، التي توصلت لها موسيقى المحيط. تعاون فيه الإنجليزي دنيس هدلستون مع الأمريكي زاك فرزيل المشتهر باسم زاكي. الاثنان معروفان على كل حال في مدرسة محيط الطنين، التي يعبر اسمها عن أسلوب تأليفها. يشير الاسم إلى اعتماد هذه المدرسة على أصوات مستمرة، على نغمة واحدة كأنها أزيز النَّحْل، تشكل خلفية صوتية غنية، تتقاطع فيها الموجات في تداخلات بنّاءة، وهدّامة، لتصنع نبضاتٍ معينة، مع استبعاد الطبول والأصوات البشرية. ذلك بحيث يقوم مخّ المستمع ببلورة شبه لحن من تلك الخلفية.
تأثر في هذا العمل كل من هدلستون وزاكي بمشروع قديم نسبيًا من المدرسة نفسها، بدأ عام ١٩٩٢، هو نجوم الجَفْن يشير نجوم الجفن إلى تلك الهلاوس البصرية، التي يظن المرء أنه يراها، حين يغمض عينيه ويفرك جفونه. لكل من بريان ماكبرايد وآدم وِلْتزي. اشتُهر من هذا المشروع عمل معروف، نوصي القارئ بمطالعته، بعنوان تذكرة زيارة. بيد أن هدلستون وزاكي ينقلان تلك المؤثرات إلى مرحلة بعيدة، أغنى في المعالجة الهارمونية، وفي استغلال تقنيات صوتية أشد تعقيدًا، وفي توظيف كل ذلك في مقطوعات أطول، تنعقد بينها علاقات متشابكة.
كما هو بيّن من عنوانه يعتبَر هذا الألبوم واحدًا من عشرات الأعمال في موسيقى المحيط، التي استمدت إلهامها من الخيال العلمي؛ وهو ما يمكن الإشارة إليه بالخيال العلمي الموسيقي. إننا إذا قلنا الخيال العلمي، انتقل الذهن فورًا إلى أدب الخيال العلمي السردي، وسينما الخيال العلمي، في حين تظل الإحالة محدودة جدًا إلى الأدب غير السردي كالشعر، وإلى الفن التشكيلي، والموسيقى. ما يعني أن مثل هذه الأعمال تسدّ فجوة سوقية باصطلاح علم الاقتصاد، حيث يزيد الطلب كمًا، ونوعًا، عن العرض. يكمن في ذلك أحد أسباب نجاح هذا الصنف من الموسيقى.
يعرف المغرمون بأدب الخيال العلمي تيمة السُّبات في رحلات الفضاء. فكرة لم يزل العلماء يشتغلون عليها من دون نجاح كبير بالنسبة للإنسان، وتعتمد على إبطاء العمليات الحيوية بتجميد الجسد؛ كيلا يشيخ، من أجل رحلات طويلة جدًا إلى أطراف المجموعة الشمسية، أو بين النجوم. المصطلح المعبر عن هذه العملية هو نفسه ما استعمله المؤلفان لعنونة العمل ككل: السبات. يتخيل المؤلفان في هذا العمل، الذي يبلغ طوله الكلي أكثر من ثلاث ساعات وعشرين دقيقة، والذي ينقسم إلى تسع وعشرين مقطوعة/حركة، الموسيقى الخلفيةَ لمثل هذا السبات الفضائي، الذي ربما ينجح البشر في تطبيقه العملي في المستقبل. لهذا يتضمن العمل حركات مفعمة بأجواء أرضية، كنوع من مؤانسة رواد الفضاء النائمين، كما يشتمل على حركات تنقل للمستمع نفسه أجواء الفضاء المظلمة، المعدنية، الباردة.
للمزيد من تشريح هيكل العمل الأساسي نلاحظ في عنونة الحركات دراما بسيطة منطقية، إذا أعدنا ترتيبها، إذ يبدأ العمل بغرفة السبات، تليها ثلاث حركات من الأجواء الأرضية لمعاونة رواد الفضاء في الدخول إلى النوم الطويل، هي على الترتيب: الكهف، والمطَر، والمدينة في الليل. تلي ذلك عشر مراحل من السبات، من السطحي حتى العميق، وتحمل الأرقام من واحد إلى عشرة. تتوالى بعدها ست حركات، تحمل كل منها عنوان الجزء رقم.. من واحد إلى ستة، وتنقسم كل منها إلى حركتين فرعيتين، تتخذ كل منهما أحد عنوانين: الفضاء العميق Deep Space، أو رؤَى أرضية Earth Visions.
في الختام ثلاث حركات بعنوان اختزال Reduction، تحمل كل منها رقمًا من واحد إلى ثلاثة. هي اختزالات لأجزاء سابقة ولاحقة في العمل نفسه؛ والاختزال في الموسيقى هو تبسيط مقطوعة بحيث يسهل تحليلها، كأنما هو إسقاط هندسي لبناء ثلاثي الأبعاد على سطح ثنائي البُعد.
ربما لا نستطيع في هذه الصورة المتطورة من موسيقى المحيط الحديث عن ألحان بالمعنى التقليدي للكلمة، كما تحدثنا مثلًا فيما سبق عن موسيقى إينو، غير أننا سنلاحظ مع تكرار السماع أن ما تكونه أدمغتنا من أشباه ألحان يتكرر بصياغات مختلفة عبر حركات العمل. برغم هذا التكرار فإن ثراء المعالجات، وتباينها، واضح. يستبعد العمل في أغلبه التعبير العاطفي، وذلك على خلاف ألبومات أخرى لهدلستون، مثل هايبرسونا، أو إنفينيتي رووم، أو بلاك سوما، وكلها ذات جماهيرية عالية نسبيًا لدى مستمعي هذا النوع من الموسيقى.
على أن أهم ما يميز هذا العمل هو قدرته الفائقة على الخداع الصوتي للدماغ، فنكاد نسمع في قلب بعض الحركات ما يشبه في الطابع، واللحن، أغاني البوب اليابانية، أو ربما إيحاءات بعناصر من طبيعة غير أرضية، كأنها بحار النشادر على المشتري، أو عواصف الميثان على أورانوس، فيما تلمع في الخلفية نجوم بارقة، توحي بها المؤثرات الصوتية مرتفعة الطبقة. بصفة عامة، وخاصة لجيل مواليد الثمانينيات من قرّاء المؤسسة العربية الحديثة بالقاهرة، تذكرنا هذه الأجواء بقصص كاتب الخيال العلمي، شاعري الأسلوب، رؤوف وصفي، الذي برع في نقل بيئة الفضاء بلغة أقرب إلى قصيدة النثر. ذلك أنها المحاولة الشهيرة الوحيدة من نوعها فيما نعلم في أدب الخيال العلمي العربي، حيث برز الأسلوب ليحتل مكانًا مساويًا للدراما.
القصور الحراري للموسيقَى
تعد نظرية المعلومات من المداخل الملائمة للشريحة الكبرى من المستمعين لتحليل الأعمال الموسيقية؛ فهي لا تعتمد على معتقدات مسبقة، ويسهل تصورها. تقوم النظرية أولًا على فهم ماهية المعلومة. إن النظام الكامل، الذي يمكن لنا توقع نتائجه على نحو حتمي، لا معلومة فيه Kivy, Peter, Introduction to Philosophy of Music, Clarendon Press, Oxford, 2002, pp. 70-71.. إن قولنا مثلُا “السماء هي السماء” لا يحمل قيمة معلوماتية؛ لأن النتيجة متضمنة في المقدمة إلى درجة التطابق. كذلك فإن العكس، الفوضَى الكاملة، كقولنا “السماء أشياء”، لا قيمة معلوماتية فيه تقريبًا؛ لأن النتيجة ضعيفة الارتباط جدًا بالمقدمة. بين هذا وذاك نجد القيمة المعلوماتية، التي تضيف جديدًا إلى ما نعرفه على نحو معقول، كقولنا “السماء لا تنفصل عن الأرض”؛ هنا يحمل القول قيمة إخبارية واضحة، هي أننا نفكر في السماء كنقيض للأرض، والعكس. لا سماء بلا أرض، ولا أرض بلا سماء. كلما توسطت العبارة بين النظام الكامل، وبين الفوضَى الكاملة، كلما ارتفعت قيمتها الإخبارية المصدر السابق..
يكتسب هذا المبدأ أهمية نوعية حين نطبقه على الموسيقى؛ بسبب أن الموسيقى – كما قال المثاليون الألمان – فن الشكل بلا مضمون. لا يعني القول السابق أن الموسيقى عاجزة بإطلاق عن نقل المعاني؛ فقد رأينا مع الأعمال السابقة مثلًا معالجات موسيقية لموضوعات، يمكن التعبير عنها باللغة. المقصود هو أننا إذا أزلنا العناوين الداخلية لحركات العمل، وعنوان العمل الكلي، لما استطعنا الربط على نحو مقنِع بين غرض المؤلف الظاهر في تلك العناوين، وبين العمل نفسه. سنسمع موسيقى ممتعة، وموحية، لكنها سوف تعني لكل منّا شيئًا مختلفًا.
هنا برز السؤال في النقد الموسيقي، وفي فلسفة الموسيقى على السواء: ألَا تَحمل الموسيقى بذاتها أيَّ قيمةٍ إخبارية؟ أليس باستطاعتها أن تمدنا بأي معلومة، إذا رفعنا عنها العناوين، وكل ما يتعلق بقصد المؤلف؟ هكذا تدخلت نظرية المعلومات لمحاولة الإجابة. في رأي النقاد، والفلاسفة، الذين حاولوا تقديم هذا المنظور، يمكن للموسيقى أن تحمل معلومة، لكنها معلومة عن الشكل نفسه، لا المضمون. يمكن بعد الاستماع إلى الحركة الأولى مثلًا من السيمفونية رقم ٤٠ لموتسارت أن نلاحظ صراعًا ما بين تيمتَيْن متعارضتين، ينتهي بانتصار إحداهما.
هذه معلومات في حد ذاتها، تمثل نوعًا من الحبكة الموسيقية المصدر السابق، ص ٨٤.. لا يمكن ملاحظة حبكة معينة في مجرد ضوضاء فوضوية، حتى إذا كانت تؤديها آلات الأوركسترا، كما لا يمكن هذا بالمثل في دقات الساعة الرتيبة، التي يمكن توقعها بصورة حتمية. أما ما بين هذا وذاك فهو مجال فن الموسيقى.
ينسحب مبدأ المعلومة سالف الذكر كذلك على الطبيعة ككل؛ فالصورة العامة لكوننا في الفيزياء الحالية هي انتقال من النظام الكامل، النقطة المتناهية في الصغر، ذات الكثافة الهائلة، نحو حالة من الفوضى الكاملة، حين يبلغ الكون المتمدد أقصَى اتساع له، حتى ينفصل كل جسيم عن كل الجسيمات الأخرى. ويطلق علماء فيزياء الفلَك على هذه الحالة الأخيرة مصطلح الانفصال السببي Causal Disconnection، أي العجز الكامل لكل شيء عن أن يؤثر أي تأثير في أي شيء.
بين النقطة الواحدة الكثيفة، التي نشأ منها الكون الأوّلي عن طريق الانفجار العظيم، وبين حالة الانفصال السببي العامة تحدُث كل الطبيعة التي نعرفها، والتي يمكن أصلًا معرفتها من زاوية اشتمالها على معلومة، هي المتعلقة بالتأثير السببي لشيء في شيء آخَر. أما ذلك الانتقال التدريجي الدائم من النظام إلى الفوضى فهو ما يدعَى بالإنتروبيا، أو القصور الحراري، الذي يعبر عنه القانون الثاني للديناميكا الحرارية.
إن موسيقى الضوضاء محاولة للحركة بين النظام الصوتي الكامل والفوضَى الصوتية الكاملة. بيد أنها حركة تتم بالعكس: من الفوضَى إلى النظام، وذلك من أجل استكشاف طبيعتنا الإدراكية، من حيث كونها تميل إلى استبصار النظام في درجة ما من الفوضى، ومع توافر موجِّهات معينة. يمكن القول إنه قصور حراري معكوس. بناء عليه يمكن القول أيضًا إن القصور الحراري للموسيقى يسير بعكس اتجاه القصور الحراري للطبيعة.
هكذا تحمل لنا موسيقى المحيط، بما هي موحية بنظام، صورة مصغرة ومعكوسة للطبيعة. ربما لم يتضح ذلك مع بداياتها الأولى. ليس هذا واضحًا مثلًا في عمل موسيقى للمطارات؛ لأنه يتضمن نظامًا واضحًا. يعبّر عمل بريان إينو سابق الذكر عن ضوضاء صالات السفر، وما يعتمل في نفوس المسافرين المترقبين للمغادرة. أما عمل هدلستون وزاكي، السُّبات، فهو مثال على الفوضى الحبلى بالنظام.
قد نقول بالتالي إن السبات يملك درجة أكبر من الإنتروبيا، من القصور الحراري، مقارنة بـ موسيقى المطارات، وإن هذا ما جعل له قيمة إخبارية أكبر؛ إذ يقترب أكثر من الحدود الفاصلة بالضبط بين الضوضاء والموسيقى. لهذا أيضًا يحمل لنا دهشة، هي سر البناء الفني الفريد؛ فإن السامع يندهش حين يراجع السبات، فلا يجد في بنيته نفسها ذلك النظام، الذي قام دماغه بصوغه تلقائيًا مع تكرار السماع؛ ولا دهشة بلا معلومة جديدة، غير متوقعة.
عُرفت موسيقى المحيط بقدرتها على إدخال السامع إلى حالة من التأمل، لكن بعض أعمالها، مثل السبات، هي نفسها موضوع للتأمل العميق، الذي يكشف عن طبيعة إدراكنا الباحث بطبيعته، بما هو عقل إنساني، عن النظام، وعن الموسيقى، كما يكشف في آنٍ عن تصورنا للطبيعة، كونها مرحلة بين دقات الساعة المتوقعة دائمًا، وبين الضوضاء المستمرة أبدًا.
المَشهَد الصوتي
أمكن دائمًا للموسيقى، حتى الكلاسيكية منها، التي وصلت فيها البنية، وبلغ فيها اللحن، أقصى ما وصلت إليه الموسيقى في درجة النظام، والتبلوُر، التعبير عن المشهد الطبيعي المرئي. بالنسبة للعارف بأشهر الأعمال الكلاسيكية يتبادر إلى الذهن عادةً، وتلقائيًا، عمل معين، هو السيمفونية السادسة لبيتهوفن، التي عبر فيها الأخير عن مشاهد الريف الطبيعية، واستعمل فيها الآلات لتوحي بأصوات من جهة، وبمرئيات من جهة أخرى، أصوات مثل أصوات الطيور، وخرير مياه الجداول، ومرئيات مثل البرق، وتجمُّع الغيوم. هناك أعمال كلاسيكية كثيرة قبل بيتهوفن، وبعده، حاولت بلوغ الهدف ذاته، مثل الفصول الأربعة لفيفالدي، أو البحر لكلود ديبوسي. لكن الأمر مع موسيقى المحيط مختلف جوهريًا.
لا تحاول موسيقى المحيط نقل مشهد واقعي بمسموعاته، ومرئياته، كهدف أساسي. ربما نقلت المشهد بهذا المعنَى، لكنه ليس غايتها الأولَى. المقصود بالمشهد الصوتي Soundscape مختلف، وذو علاقة بالمشهد الواقعي في آنٍ. حين نتأمل في مقطوعة المدينة في الليل من عمل السبات، نجد عناصر من مسموعات المدينة في الليل، ضوضاء حَضَرية هادئة؛ فهي ليلية، لكن بقية المشهد لا هو حضري، ولا هو ليلي، ولا هو واقعي.
المشهد الصوتي، الذي تقدمه لنا موسيقى المحيط عادة، هو مشهد افتراضي يتضمن عناصر واقعية، تصنعه الموسيقى الإلكترونية، والرقمية، وترتحل فيه الأذن، ويتجول فيه العقل، عبر مساحات متداخلة من التآلفات، والتناقضات، وما هو رتيب، وما هو فريد، ما هو مستمر، وما هو نابض عبر أطياف غنية من طابع الصوت Timbre الذي يختلف من آلة موسيقية إلى أخرى، ومن صوت رقمي إلى صوت رقمي سواه.
إنه التوزيع، والتلوين الأوركسترالي، حين يصير هدفًا في ذاته. إذا كنا نختبر عادة أحلامًا معتمدة على المرئيات، والحركة، حتى نقول “رأيتُ كذا في المنام”، أو ربما المسموعات، حين يقال أحيانًا “قال لي فلان في الحلم”، فإن موسيقى المحيط محاولة لتقديم حلم سمعي غير لغوي، حلم صوتي. فهل يمكن أن نقول إنه حلم موسيقي؟ لا نعتقد ذلك؛ فإن الموسيقى في حالة المشهد الصوتي قائمة على خداع الدماغ كما قلنا، على طبيعة في عقولنا ذاتها، تنحو تلقائيًا نحوَ إيجاد موسيقى في الضوضاء، لكنْ فقط الضوضاء، التي تسمح بذلك. من ثمَّ فرادة هذا النوع من الموسيقى، وسبب اهتمامنا بها.
الصَّحْو في المطار والنوم في الفضاء
عسَى أن يكون القارئ قد التفتَ – كما التفتنا – إلى العلاقة بين موسيقى للمطارات، وأصوات للسفر الطويل في الفضاء، ألا وهي فكرة السفَر في حد ذاتها. فهل هي مصادفة جمعت بين بريان إينو، وهدلستون، وزاكي؟ هل هو تأثر من جهة الأخيرَيْن بالأول، وهو أسبق منهما؟ ليس بالضبط. يسترعي انتباه البعض كيف أننا حين نفكر في الموسيقى، أو نحاول تذكرها، أو حين نسمعها بتركيز لإبداء رأي، عادة ما ننظر إلى الأعلى، ولا نرى شيئًا هناك. ننظر إلى سماء غير موجودة.
إننا نحاول عَزْلَ أنفسنا عن فوضى الوجود المرئي غير المنظّم، أو عن أي نظام سوى نظام الموسيقى التي نسمعها أو نتذكرها؛ وإذا كنّا نستمع إلى إلقاء قصيدة، فقد ننظر إلى النصّ إذا توافر بين أيدينا، كما ننظر كذلك إلى العمل التشكيلي حين نتأمله، ولكن الموسيقى لا يمكن النظر إليها؛ لأنها ببساطة كائن بلا جهة.
ليس للموسيقى شمال أو جنوب، ولا يمين أو يسار، ولا أعلى، ولا أسفل. قلنا في مقال كيف تسرق سيمفونية؟ على معازف إن سرقة عمل موسيقي مستحيلة، إذا كنّا نعني السرقة بمعناها في سرقة لوحة فنية. ذلك أنْ ليس للموسيقى مكان معين. هذا هو بيت القصيد؛ الموسيقى نفسها حالة من مغادرة المكان بما هو مكان. ليس بمعنى مغادرة أجسامِنا مكانًا إلى مكانٍ سواه، بل مغادرة العقل للمكان كأبعاد طبيعية، مغادرة الجسد نفسه، والسباحة في تيار زمانيٍّ خالص، هو تيار الوعي.
إنه المجال، الذي لا نميز فيه إلا بين ماضٍ، وحاضر، ومستقبَل، بدلًا من تفريقنا بين طول، وعرض، وارتفاع. يحقق الأدب ذلك أيضًا؛ فهو فن المفاهيم المجردة، لكن الموسيقى تصنع ذلك من دون أن تكون مجردة، فهي محسوسة بكل تأكيد. ما يميز الموسيقى فعلًا هو كونها صيرورة، عملية تحوُّل عامة، محسوسة، ومسموعة.
مِن يقظتنا في مطار بريان إينو، ونحن نفكر في مستقبل السفَر، وحاضر الانتظار، وماضي الرحيل، إلى سباتنا المديد في سفينة هدلستون وزاكي الفضائية، إذْ نتذكر مَشاهِد الأرض القصية الصوتية، ونندهش أمام ضوضاء الكواكب القادمة، وما ينتظرنا من السُّدُم الكونية، ننتقل في الحالتين بالجسد في الخيال، ومِن الجسد في الواقع. فبالرغم من أن العملين يصفان مَشاهِدَ صوتية للمكان، الذي نوجَد فيه بأجسامنا، فإننا نتحرك أثناء حالة السماع نفسها إلى ما وراء تخوم الجسد. إنها مجرد حركة بلا نهاية، إذا كان السفر الفعلي مسارًا ذا ختام. موسيقى المحيط قادرة على أن تحملنا في رحلة عبر الجسد إلى المحيط بالجسد، محيط شفاف، غير مرئي، قد لا نتجسد بَعده أبدًا.