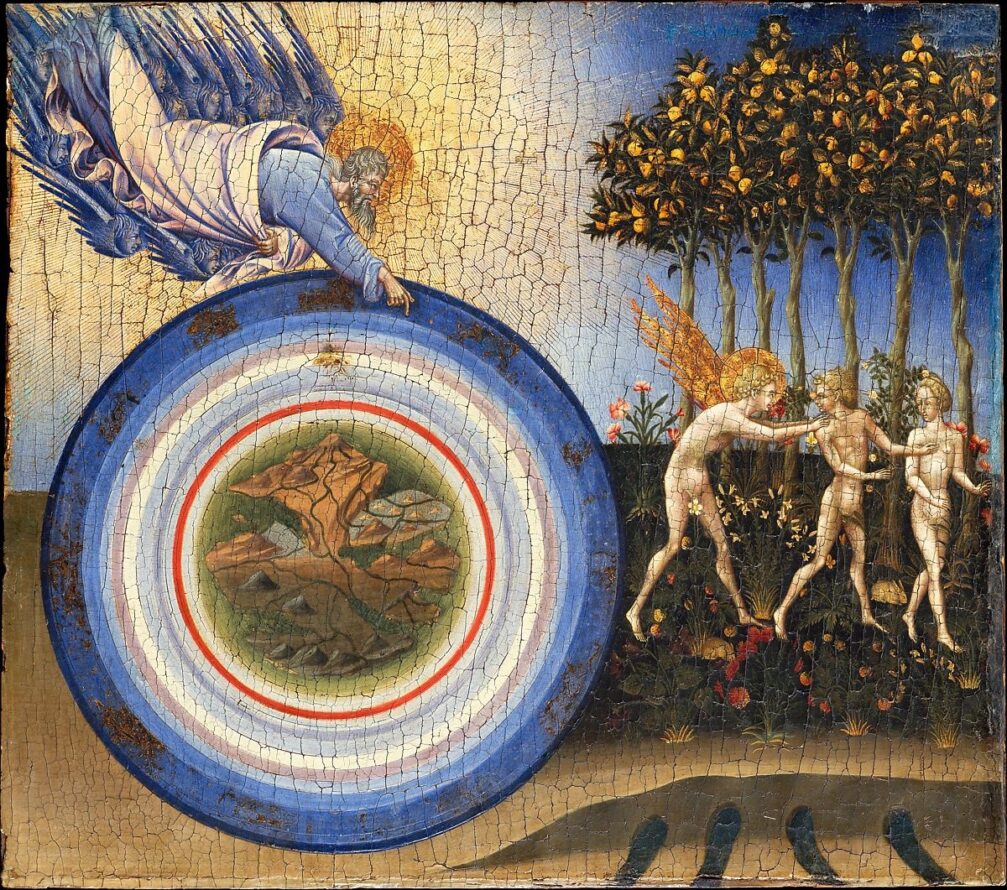
في المقالات السابقة المنشورة على معازف في موضوع فلسفة الموسيقَى، ناقشنا طبيعة الموسيقى بما هي كائن في العالم، وليس فقط بما هي فن. وتطرقنا إلى جانب هام من عِلم وجود الموسيقَى أنطولوجيا الموسيقى: المجال الفلسفي الذي يدرس طبيعة وجود الموسيقى، وفيما تختلف مثلاً عن وجود موضوعات الطبيعة المادية، أو الأفكار العقلية، وغيرها. ولا تكاد توجد فيه كتابات عربية أساسية إلى الآن في مقال زمن الموسيقى ومكانها، وجوانب تطبيقية في لاهوت السيمفونية التاسعة، والتأويل الموسيقى للعالم. في هذا المقال ننطلق إلى أفق أبعد، هو أبعاد الموسيقَى الزمانية والمكانية، وكيف تختلف فيها عن الطبيعة، فيما يصنع مقابلة بين الطبيعة والموسيقَى. لهذا يضع المقال الحالي الزمان الموسيقيّ في سياق فلسفة الزمان بشكلٍ عام.
يعني تعبير الموسيقَى بما هي حجم زمني أن الموسيقَى تقدم لنا ثلاثة أبعاد زمانية، في مقابل بعد زماني واحد في علم الطبيعة. وإذا كانت الأبعاد المكانية الثلاثة (الطول والعرض والعمق) تقدم لنا الحَجْم، فإن الأبعاد الزمانية الثلاثة تكوّن لدينا حجمًا زمنيًا إن جاز التعبير. وقد اتجهت فلسفات الزمان، من أرسطو إلى ما بعد آينشتين، إلى نقض فكرة أن الزمان بُعد مغاير في طبيعته للمكان، ليندمج الزمان مع المكان في مفهوم الزمكان، كما سنرى باختصار. صحيح أن هذه النتيجة قد انتهى إليها أرسطو في القرن الرابع ق. م، لكن تطورها في القرن العشرين كان ذا أساس علمي مختلف، قائم على منهجية العلم المعاصر. وقد أوشك مفهوم الزمان التقليدي (الذي يمرّ علينا) أن ينتهيَ في الفيزياء الحديثة؛ ذلك أن تصورنا عن الطبيعة مَكَانيٌّ بالدرجة الأولى، أما الزمان فمنطقي أن يكون بُعدًا وحيدًا (مَسَافِيًا) هامشيًا، أي مسافة زمنية بين حدثَينِ، مقارنةً بالمسافة المكانية بين شيئينِ. ليس هذا هو التصور الواقعي بالضرورة، ولا الوحيد الممكن بالضرورة، بل هو المسار الذي انتهت إليه الفيزياء القديمة والكلاسيكية والحديثة تاريخيًا. هي ظاهرة تاريخية، لها من العوامل ما يفسرها، لكن هذا يخرج عن موضوع البحث الحالي. ما يتعلق بمبحثنا هو تصورنا عن الطبيعة، وكيف كان بالإمكان أن يختلف جذريًا، ليؤدي إلى فيزياء مختلفة. هل يمكن أن تقدم الموسيقى مثل هذا التصور؟ هذا ما سنختبره في هذا الفصل كعنوان جانبي، لكن مهمة هذا الفصل الرئيسة هي تحليل الزمان الموسيقي، أو الانتقال من تاريخ اختزال الزمان في الفيزياء إلى زمان اختزال المكان في الموسيقَى.
١- إحداثيات الزمان الموسيقي
إن كل فلسفات الزمان، التي سيلي بإيجاز عرضها، قد افترضت أبعادًا مكانية ثلاثة وبعدًا واحدًا زمنيًا هو الزمان. صحيح أن بعض النظريات لم تتعامل مع الزمن أصلاً كبُعد، مثل أرسطو نفسه، الذي اعتبره مجرد عدد نعدّ به الحركة، لكنه على أية حال لم يفترض تعدد الأبعاد الزمانية. كما أنه من الصحيح أن بعض النظريات افترضت أكثر من زمان، كما يمكن أن نجد لدى أفلوطين وتوماس الأكويني، لكنهما لم يفترضا أن هذين الزمانين من أبعاد الطبيعة، بل ظلت الطبيعة ذات زمانٍ واحد، أما الزمان الآخَر، السرمدية، فهو خاص بالإله ولا يمكن لنا اختباره مباشرة، لكن يمكننا تخيله نوعًا. حتى هذه السرمدية فهي أقبَل لتفسيرها في ضوء تصور منكوفسكي عن العالم المكاني البحت مربع الأبعاد؛ فربما لو كان أفلوطين فيزيائيًا معاصرًا لافترض أن زمان الألوهة عبارة عن مكان ذي بعد مكاني إضافي، بحيث يَرى الإله، أو الواحد، كل ما في الزمان بنظرة واحدة في هذا المُجسَّم الفائق، كأنما ينظر إلى لوحة مبسوطة على المكان ثنائي الأبعاد أو ثُلاثيها، وربما العكس، لو كان منكوفسكي فيلسوفًا إشراقيًا هيللينستيًا.
كما يمكن رصد ذلك الخط المستمر من ديكارت إلى كانط: الزمان كطريقة لحساب السرعة عند ديكارت، والزمان كطريقة تفكير عند جون لوك، ثم كتصور عقلي يتأسس على مقولات الديمومة والتعاقب والتزامن عند كانط في نقد العقل الخالص، ثم كيف تطور ذلك الخط عند هيدجر، ليغدو الزمان ظاهرة وجودية بحتة، هو تصور الإنسان عن نهايته بالموت المحتوم في الوجودية. وقد ظل الزمان في ذلك السياق كذلك بعدًا واحدًا لا يتعدد.
مع رايشنباخ وجرونباوم وراسل، نظريات التعاقب السببي والتعاقب المنطقي، ظل الزمان كذلك بعدًا واحدًا. تقوم تلك النظريات عند الأعلام الثلاثة المذكورين على أساس أن فكرتنا عن الزمان ما هي إلا طريقة للربط بين الأحداث، سببيًا أو منطقيًا. ربما كان السبب هو الواحدية لا العكس: بمعنى أن نظريات التعاقب السببي والمنطقي تأسست أصلاً على واحدية الزمان، لا العكس. ربما لو افترضتْ تعددية الزمان لما أمكن تصور مثل هذه النظريات بدءًا. أما مع النسبية فقد انهار الزمان، وأصبح المكان مربع الأبعاد. ومع منكوفسكي Minkowski صار الزمان أسلوبًا للربط بين أشياء لا أحداث، مثل مَشاهد الفيلم المنفصلة في المكان، والتي إذا عرضناها بسرعة معينة، ظهر لنا أنها تتحرك وتتفاعل، وتتأثر بعلل معينة فيها، بحيث يلي اللاحقُ السابقَ، لكنها في الأصل متفرقة. أي أن سرعة وقوع الأحداث لدى منكوفسكي هي السبب في تصورنا عن الزمان، الذي هو في الأصل غير موجود. وهو ما يعني أن الزمان في كل ذلك المسار قد آلَ من الواحد إلى الصِّفر تقريبًا.
فيما سبق ظل الزمان يعبَّر عنه بإحداثي واحد فقط، أي أنه كان أحادي الإحداثيات، كمسافة، بخلاف المكان ثلاثي الإحداثيات. فإذا أردتَ تحديد موعد معين، فستفكر في إحداثي زماني واحد، هو الآن، أو المستقبل، لكن الزمان الموسيقي مختلف بهذا الصدد؛ فلا يمكن تحديد زمن حدث موسيقي معين بإحداثي واحد، إلا إذا كنا نقيس الزمان الموسيقي الطولي بالزمان الدوري الذي للساعات وأجرام السماء، كأن نقول: عند الدقيقة الأولى من هذه السيمفونية وقع كذا مثلاً. هذا قياس يعتمد على الزمان الطبيعي، لا الموسيقيّ، ولهذا فهو غير دقيق؛ فحتى الأوركسترا نفسها مع المايسترو الواحد، لا يمكنها تحديد زمن حدث موسيقي ما في المقطوعة اعتمادًا على الزمان الدوري بشكلٍ قابل لإعادة الإنتاج؛ نظرًا إلى اختلاف مدة العزف في كل مرة.
بالتالي لا يبقى لنا إلا أن نحدد موقع الحدث المُراد تحديده وفقًا لإحداثيات الزمان الموسيقي نفسه، وعندئذٍ سنقول بشكلٍ أكثر دقة: الحدث (س) في المقطوعة، الذي وقع بعد الحدث (ص)، مع ميزان كذا وإيقاع كذا. التعاقب بين الحدثين (س) و(ص) درامي، وهو الإحداثي الدرامي، يليه الميزان، الذي يحدد عدد الوحدات الإيقاعية وطولها في المازورة، ثم الإيقاع، الذي استعمله المؤلف للمقطوعة، أو هذا الجزء منها.
وقد نرى مع برامز مثلاً، في الحركة الرابعة من سيمفونيته الرابعة كيف استعمل عدة إيقاعات على الميزان نفسه (مقام مي الصغير، مصنف ٨.). هذه الإيقاعات، وذلك الميزان، ليسا ضروريين لتحديد موقع الحدث؛ فقد نكتفي بالبعد الدرامي، لكن ذلك الاكتفاء لا يبين لنا هيئة التعاقب بين الحدثين (س) و(ص) من جهة، كما لا يبين طبيعة كل منهما أصلاً (وهي نقطة بالغة الأهمية)؛ لأن كلًا منهما يتحدد على حدود الآخَر، وهي مسألة إشكالية، تتطلب إحداثيات أعلى، ثم أعلى؛ لتحقيق التمايز الكافي بين (س) و(ص). لذلك فالتحديد الدرامي البحت غير دقيق، كأنك تحدد موقع شيء ما في المكان غافلاً عن بعد العمق مثلاً: “هناك في ذلك المبنَى … لكن في أي طابق مثلاً؟”
وهكذا نصل إلى أن أبعاد الزمان الموسيقي مثلثة، كأبعاد المكان الطبيعي: الدراما، والميزان، والإيقاع. وهي أبعاد، تتداخل فيما بينها؛ لتصنع التعاقب الموسيقي، وذلك دون بُعد مكاني. لكن الموسيقى لا تتحرك في هذه الأبعاد، كما قد يساء فهم النتيجة السابقة. الموسيقَى تُنتِج هذا التصور الزماني المركب في العقل، تمامًا كما ينتِج الجسمُ المتحيز في الفضاء فكرتنا عن مكان ثلاثي الأبعاد. ولهذا سبق القول في المقالات، التي أحلنا القارئَ إليها في التمهيد، بأن الموسيقى صيرورة Becoming بحتة، مُنتجة للزمان، هو الزمان الموسيقي. لكن ماذا عن إنتاج المكان؟
٢- إنتاج المكان وإنتاج الزمان
قلنا في المقالات السابقة إن الموسيقى منتجة للمكان بعدة طرق، أهمها الهارموني، الذي هو العنصر التزامني-المكاني الأساسي في الموسيقى. فبرغم أن الموسيقى – كما سبق توضيحه – صيرورة نقية، لكنها تولِّد تصورًا عامًا عن المكان حين نسمعها، والسبب الرئيسي في ذلك هو التآلف في الموسيقى الهارمونية، إضافة إلى أسباب أخرى جرى تحليلها في مقال زمن الموسيقى ومكانها. ما يعني أن هذه الصيرورة المطلَقة تُنتج عَرَضًا، وكناتج جانبي، مكانًا. وهو – بشكلٍ ما – ما وقع في فلسفات الزمان الطبيعي، لكن بالعكس.
فالزمان الطبيعي ناتج جانبي للثالوث المكاني في الطبيعة؛ فهو عند أرسطو عدد للحركة التي تحدث في المكان. هو أسلوب لرصدها كما اتفق في ذلك ديكارت وجون لوك. وقد رأينا كيف أن التزامُن مقولة أساسية في تصور الزمان عند كانط في نقد العقل الخالص. وهو عند رايشنباخ وجرونباوم وراسل نتيجة لإدراك التعاقب السببي والمنطقي. السؤال: هل هذا تعاقب بين أحداث أم أشياء؟ فلو أنني اكتسبت لونًا غامقًا مثلاً للبشرة، فهل هذا تعاقب بين حدثين، أم رابط ما بين شيئين مختلفين؟ بكلمات أخرى: هل ظللتْ أنا أنا بعد أن تغير لون بشرتي؟
هنا يأتي دور النسبية وتأويل منكوفسكي لها؛ ليفسر الأمر من وجهة نظر معينة: هذا تعاقب بين شيئين، لا حدثين. بالأحرى – من وجهة نظر الكون رباعي الأبعاد المكانية – هو تجاور، ومن وجهة نظر التعاقب السببي والمنطقي أننا قد ربطنا سببيًا أو منطقيًا بين شيئين، بين جسمين، واقعين في المكان. هذا يعني أن الزمان الطبيعي كيان تخيلي عقلي بحت، كمُثُل أفلاطون، ناجم عن تفاعل العقل مع المكان. يخطو هيدجر خطوة أبعد في الحقيقة، ليفيد أن هذا التصور ظاهرة وجودية، تتعلق بإدراكنا لطبيعة النفاد نفسها: أن وجودنا متناهٍ، وأننا نشرف على الزوال في كل يوم. وبالتالي هو ليس تصورًا طبيعيًا – لدى هيدجر – بل هو مستقل عن الطبيعة، عن الحركة، وعن المكان نفسه. والنفاد صيرورة معينة. إذن يمكننا أن نستنتج أن الزمان الوجودي تفاعل للإدراك مع صيرورة النفاد، وفكرة النهاية القادمة المحتومة. لهذا نفى بعض الوجوديين فكرة السرمدية نفيًا قاطعًا. الزمان الوجودي تفاعل مع الصيرورة بما هي تعاقب بين الوجود والعدم.
إذن فالزمان الموسيقي عكس الزمان الطبيعي؛ الأول أصلي مثلث الأبعاد، والثاني فرعي أحادي البعد. ولعل السؤال هو: لماذا توقف إدراك البشر للكون عند أربعة أبعاد، ثلاثة منها مخالفة لأحدها، بهذا العدد في الحالتين: الموسيقي، والطبيعة، وبالتوزيع النوعي نفسه، وإنْ كان معكوسًا؟ على أية حال فالمكان الموسيقي عكس المكان الطبيعي؛ الأول أحادي البعد وفرعي، والأخير ثلاثي الأبعاد وأصلي. وهو أساس فكرة الكون الموسيقي.
٣- الكون الموسيقيّ والكوجيتو الموسيقي
الكون الموسيقي طبيعة مقلوبة؛ لها ثلاثة إحداثيات زمنية، وإحداثي واحد مكاني، عكس الطبيعة المعتدلة (الاصطلاحية) ذات الأبعاد المكانية الثلاثة، والبعد الواحد الزمني. ويمكن القول كذلك إن الموسيقى زمان، والطبيعة مكان. الموسيقى رياضيات متحرّكة، والطبيعة رياضيات ثابتة. الموسيقى هندسة صيرورية، والطبيعة هندسة تشريحية، صيرورة تفرقها الهندسة إلى شرائح لا نهاية لها من الأشياء، لا الأحداث، بسرعة الضوء هذا سليم فيزيائيًا، ويمكن الرجوع في ذلك إلى مصدر منكوفسكي المذكور سابقًا. وهي فكرة تأثر بها جوليان باربور، واشتهر بتطويرها إلى كون بلا زمن على الإطلاق، واعتبرها ثورية. يرى باربور أنه، وبإضافة كل الدوال الموجية الممكنة، فإن كل الأحداث (واقعة) على مستوى مكاني مربع الأبعاد، لكنها لا (تحدُث) بمعنى تجري في زمن. إن كوننا – في اعتبار باربور – ليس نتيجة لمرور الزمن، بل حصيلة لانهيار كل الدوال الموجية الممكنة بشكلٍ معين؛ نظرًا لقوة الاحتمالات القائمة. ومع إدخال عنصر انهيار الدوال الموجية انهار الزمان كمفهوم. وهنا تم اختزال الزمان هندسيًا إلى مكان رباعي الأبعاد. لكن الكون الموسيقيّ على العكس: صيرورة تامة، ملتئمة، غير ممزقة.
يعبّر الكون الموسيقي عن تداخل الأزمنة: فالدراما تتداخل مع الميزان، وكلاهما يتداخل مع الإيقاع، ليحدد ذلك التداخل موقع حدث موسيقي معين. وبينما يلزم الزمان لتحديد شيء في العالم الطبيعي، فإن المكان كذلك، التزامُن، ضروري لتحديد موقع حدث موسيقي في مقطوعة محددة. وفي الكون الموسيقي إذًا لحظة، وتزامُن. وهو ما يقف على الضد من زمان آينشتين الخالي من اللحظة، بما هي تزامن مطلَق لحدثين أو أكثر. ففي الموسيقى – على العكس – لحظة كاملة التبلور، يمكن تحديدها بسهولة، وهو ما يؤدي إلى تصور كون غير نسبي. بتعبير آخَر: الكون الموسيقي لا يخضع لنظرية النسبية.
الكون الموسيقي نيوتوني إلى حد معين، بمعنى انفصال الزمان المطلَق عن المكان المطلَق. والسبب في ذلك أن الموسيقى منفصلة عن المكان في الأساس، حتى لو كانت تمنحنا تصورًا عن المكان العام. وهو نيوتوني (إلى حد معين)؛ لأن أساس مطلقية الزمان فيه ليس انفصال الزمان عن المكان، بل لأنه – الزمان – هو الذي ينتج المكان؛ فالأول أصل والأخير فرع. وهو ضد-نسبوي؛ لأن المكان في النسبية هو الأصل، والزمان فرع له. لذلك أمكن في ضوء النسبية نفي الزمان، وهو غير ممكن في حالة الزمان الموسيقي، أو الكون النيوتوني. في الكون النيوتوني الدقيق الزمانُ والمكان كلاهما في المستوى نفسه من الأصالة. وقد أدّى انهيار الدوال الموجية عند منكوفسكي وباربور مثلاً إلى تشريح المكان في تصور رباعي الأبعاد المكانية، أما في حالة الزمان الموسيقي فالقضية مختلفة جذريًا؛ نظرًا لتعدد الزمان، الذي يسمح بأكثر من حدث في الوقت نفسه، وبالتالي لا تنهار كل الدوال الموجية، بل يبقى بعضها متزامنًا في صيرورة ممتدة، بعضها مع البعض. وهو ما نجده في تحليلنا السابق للهارموني، كما نجده في الكونترابنط بشكل أوضح. وربما كانت المقارنة بين الزمان الموسيقي والزمان الطبيعي أوضح على محور نظرية الكوانتم، أكثر منها في حالة النسبية.
الكون الموسيقي عالم افتراضي ملتئم، قوامه الصيرورة المجردة، الصيرورة في حد ذاتها، لا حركة النفس عند أفلاطون وأرسطو، اللذين افترضا أن الموسيقَى تعبير عن حركة النفس، ولا الإرادة عند شوبنهور، الذي اعتبر الموسيقى إرادة خالصة مسموعة. وفي فلسفات العالم الافتراضي، كنِيك بوستروم مثلاً، وقع شك أصلاً في واقعية الواقع، بمعنى أننا قد نكون أحياء في عالم افتراضي رسمتْه حولنا الإشارات العصبية. تقدم لنا الموسيقى، منذ قدم تاريخها، هذا العالم، بيد أننا – لسببٍ ما – أعرضنا عن جعله أساسًا لتصورنا عن الطبيعة والتاريخ؛ ربما لتوقنا اللا متناهي إلى خطة محكمة، فيزيائية أو إلهية، تحررنا من هذه الرحلة الشريرة (bad trip) التي هي الوعي.
في عالم اليوم، حيث ضرب هذا الشكُّ بجذوره في الواقع نفسه، لم يبقَ إلا نوع معين من الكوجيتو الديكارتي “أنا افكر، إذًا أنا موجود”؛ فلا شيء حقيقيًا سوى الوعي نفسه بهذه القضية، لكن هذا النوع يختلف عن الكوجيتو الديكارتي في أنه ليس “نقطة أرخميدس الثابتة” التي رامها ديكارت لإثبات العالم، بل هو في حالته الخامة، لا ينبني عليه شيء ولا حقيقة. بالمقابل، تقدم الموسيقى نوعًا آخَر أكثر وجاهة ربما من الكوجيتو الديكارتي الخامّ، هو “أنا أصير، إذًا أنا موجود fio, ergo sum”؛ لأنه لا بد من شيء ما تحدث فيه هذه الصيرورة. السبب في وجاهته النسبية – الفِيُو مقارنةً بالكوجيتو – أن الوعي نفسه لا يثبت وجوده في العالم الافتراضي الكومبيوتري؛ فقد يكون حصيلة ترابط بين أكثر من وعي، وقد يكون حصيلة الوعي البشري، وهو ما يفسر وجود درجة من الموضوعية، أو بين-الذاتية في العلم الطبيعي. وهنا تصبح الصيرورة دليلًا أكثر دقة على الوجود.
تتخذ هذه الصيرورة أشكالًا مختلفة، تمامًا كما يتخذ المكان هيئات مختلفة، وأشكالها المختلفة هي الأنماط المتباينة للتطور بما هو تطور. وهو ما يمكّننا من دراسة الموسيقى كأنماط للتطور المحض. وهو كذلك ما يفتح المجال لموضوع أشمل، ذي ناحية تطبيقية، هو الموسيقَى بما هي أنماط للتطور الخالص.
٤- الموسيقَى بما هي أنماط للتطور الخالص
يعتمد التأويل الموسيقي للعالم في اعتبارنا على عدة دعامات، ذكرناها في مقال التأويل الموسيقي للعالم، أهمها في هذا المقام هو أشكال الصيرورة. تقدم لنا الأعمال الموسيقية المختلفة، وخاصة في الموسيقى الخالصة، منظورات متعددة لفهم التطور من خلال نمط الحركة الذي تنتجه، وبالتالي تمكن إعادة فهم الحركة في الطبيعة طبقًا لها. ويمكن هنا التمثيل بأربعة أنماط للحركة: نمط موتسارت الثنائي، ونمط بيتهوفن الجدلي، ونمط رحمانينوف الغائي، ونمط شوستاكوفتش السرطاني.
شرحنا في المقال المذكور أعلاه كيف أن الأنماط الأربعة تختلف في أسلوب تطوير اللحن، أو التيمة، وبالذات في قسم التفاعل. نمط موتسارت هو الأبسط بين الأربعة، والأكثر انتظامًا، وهي خاصية اشتهر بها موتسارت إلى الحد الأقصى بين كل الموسيقيين، أي خاصية البساطة والنقاء والتوازن، حتى ليكاد يكون عنوانًا في حد ذاته للتكامل ونهائية البناء. وهو نمط متسق، يتعرض للصراع والتفاعل بين عناصر العمل في حدود ضيقة، ولا يعتمد على آلية الاشتقاق اللحني إلى الحد الذي تطور مع بيتهوفن مثلاً فيما بعد. ولذلك فالهدف الأساسي من التطور الموتسارتي هو تحقيق التوازن والتناسب والسيمترية في العمل.
يختلف الأمر مع بيتهوفن؛ فالتوازن ليس كلمة السر عنده، بالرغم من أنه كذلك يحقق تكاملاً بين عناصر البناء، وبين آلات الأوركسترا، إلى حد لا يقل عنه في حالة موتسارت، لكن بشكل مغاير. فالتطور البيتهوفني جدلي، بمعنى أن العناصر السابقة في العمل، ولتكن تيمة معينة مثلاً، تستعاد فيما بعد، في قسم إعادة العرض، أو الكودا، بشكل مغاير عما ظهرت به سابقًا. لا وجود لما هو جديد أو يظهر للمرة الأولى عند بيتهوفن. لذلك لم يستحِ بيتهوفن من بناء الحركة الأولى من سيمفونيته الثالثة على لحن لموتسارت، فالقضية عنده ليست ما اللحن؟ بل كيف اللحن؟، بمعنى أن اللحن في حد ذاته ليس بهذه الأهمية، كما هو لدى موتسارت، بل معالجة اللحن. لم يكن بيتهوفن ملحّنًا متميزًا مثل موتسارت، الذي برع في فن الأوبرا إلى حد إطلاق لقب الطفل الإلهي عليه، بينما لم ينجح بيتهوفن في تلحين سوى أوبرا واحدة (فيدليو)، وبعد معاناة شاقة، في مقابل ٢٣ أوبرا لموتسارت. يركز بيتهوفن أكثر من موتسارت بشكل ملحوظ على الاشتقاق اللحني، وعلى التلاعب بطرق الاشتقاق، حتى لتكاد تكون بعض أعماله، كالسيمفونية الخامسة مثلاً، كلها مشتقة من تيمة واحدة صول صول صول مي-بمول. وبينما يقدم موتسارت ألحانه سابقة التجهيز، يعلنها في بداية العمل، يقدم بيتهوفن في البداية وحدات لحنية، لا يمكن أن تكون لحنًا، لكن اللحن يتكون منها كمرحلة ضمن سياق العمل. اللحن إذًا مرحلة عند بيتهوفن في العمل، لكنه عند موتسارت الوحدة الأساسية للعمل. لهذا يبدو موتسارت ملحنًا، إذا ما قورن ببيتهوفن من هذه الزاوية. ونمط التطور الذي فيه تظهر العناصر باستمرار كمشتقات من بعضها البعض هو النمط الجدلي في الفلسفة، بحيث تظهر الوحدة العضوية للعمل كتآلف بين الأضداد، وليس كنفْيٍ لهذه الأضداد. ومن الغني عن الذكر أن العمل عند موتسارت يحاول قدر الإمكان تجنب التناقض، لا تجاوزه نحو وحدة أعلَى كما هو الحال عند بيتهوفن. وهذا هو سر الفارق بينهما في نمط التطور.
كان اللحن كذلك جوهر العمل عند رحمانينوف، لكن بشكلٍ جد مختلف عنه في حالة موتسارت؛ فاللحن عند موتسارت كما قلنا هو وحدة بناء العمل الأساسية، لكنه عند رحمانينوف غاية العمل. يقوم العمل عند رحمانينوف على وحدة التماسك والتفكك؛ فالعمل يبدو مفككًا، فيه شبهة نظام في البداية، لكنه لا يلبث إلا أن يتجاوز هذا التفكك نحو وحدة معينة هي انتظام اللحن، وهو ما يتبين بوضوح في الحركة الثالثة من كونشرتو البيانو الثالث مثلاً لرحمانينوف. إن رحمانينوف يغرق المستمع في البداية بالزخارف المتصارعة، والمتآلفة، بهدف الوصول إلى اللحن، وهذا طبيعي من موسيقار اشتهر أصلاً بجمال ألحانه الخارق. لم تكن هناك فرصة لدى رحمانينوف للتضحية باللحن كما فعل بيتهوفن نوعًا؛ والسبب هو عدم القدرة على التضحية بكل هذا الجمال، كما لم يتنازل رحمانينوف عن قدرته كذلك على التركيب. ولهذا كانت الصيغة التوافقية بين اللحن وبين التركيب عنده هي وحدة التماسك والتفكك. التفكك مرحلة نحو التماسك، والتماسك هو اللحن. يظهر لنا هنا عنصر هام في التطور عند رحمانينوف، هو الغائية. فاللحن يبدو للمستمع كأنه الغاية من العمل التي يسعى إليها كل بناء الحركة. الكون الرحمانينوفي كون غائي، يبحث باستمرار عن الوحدة والنظام. وهو حين يصل إليها ينتهي العمل (الكونشرتو الثالث مثلاً)، وحين يفقدها ينتهي العمل كذلك (الحركة الأولى من السيمفونية الثانية مثلاً)؛ فالوصول إلى الغاية نهاية للطريق، وضياع الطريق إلى الغاية نهاية للطريق أيضًا. لذلك تنتهي أعمال رحمانينوف إما بالتجلي الكامل للحن-الغاية، أو بالتحلل إلى وحدات أولية، تنقشع تدريجيًا في الفراغ. وليس من الغريب إذًا أن يقتبس رحمانينوف من dies irae، الترنيمة الجريجورية القروسطية، في أغلب أعماله في مواضع مفصلية: في الانتقال من لحن إلى آخر، وفي التفاعل بين الألحان.
أما نظام شوستاكوفيتش فهو قريب الصلة من نظام رحمانينوف من وجهٍ، هو شبهة النظام، أي أننا نشتبه دائمًا في وجود نظام خلف تلك الفوضى التي يقدمها لنا، وبحيث يتحرك العمل ككل على الخيط الرهيف بين الموسيقى والضوضاء، دون أن تزل قدمه في أي منهما. بينما يتحرَّى رحمانينوف طريق الغاية، فإن شوستاكوفيتش يقدم نظامًا لا غاية له سوى المزيد والمزيد من التطور والتكاثر السرطاني المخيف. لهذا يعلي شوستاكوفيتش من شأن التركيب إلى درجة تلاشي اللحن كلية، والاكتفاء فقط بتيمات لا تتطور إلى لحن، كما هو الحال مثلاً عند بيتهوفن.
الختام | نتائج ومناقشة
أ- الأحجام الزمنية وفلسفة الطبيعة
حاولت في الصفحات السابقة تحليل كون موسيقي كامل الإحداثيات، يقف في مقارنة مع هندسة الكون الطبيعي. ولذلك فقد تطور البحث من الزمان الموسيقي إلى الزمكان الموسيقي؛ وذلك بعد إضافة بُعد مكاني، بما هو تزامني، لأبعاد الموسيقى. وأبعاد ذلك الكون تتحدد كأبعاد الكون الطبيعي في أربعة: يحدث بعد كذا (أبعاد زمنية)، مع كذا (بعد مكاني)، بحيث تحل مقولة المعية محل مقولة المكان. لم ينظر الفلاسفة في الغالب إلى الطبيعة بفرض تعدد الأبعاد الزمنية. هذه الفرضية قد تفسر بعض الظواهر (الخارقة) كالتواجد في مكانين في وقت واحد أو الحضور Apparition، لكن نظرًا لكون هذه الظواهر محدودة جدًا، وربما لم تحدث قط، أو لم تحدث بعدُ، فإننا نميل عادة إلى تصور أحادية البعد الزمني. فلنلاحظ أن الجسيمات تحت الذرية تتصرف بهذا المسلك الشبحي، هي قادرة على التواجد من عدم، من خلال التوتر الكمومي Quantum fluctuation، أو التواجد في مكانين في الوقت نفسه.
ربما كان افتراض تعدد الأبعاد الزمانية مناسبًا لإعادة تصور الطبيعة تحت الذرية على الأقل، والتي لها أن تفسر نشأة الكون ذاته من لا شيء. لكن هذه ليست القضية، فالمسألة هي أن الموسيقى قد تقدم فرضيات جديدة قائمة على تعددية الأبعاد الزمنية، يمكن للعلم أن يختبرها في مرحلة ما من التطور التقني. وهكذا قد يمكن حساب الأحجام الزمنية في هذا التصور، وذلك باعتبار الزمان الموسيقي متعدد الأبعاد كما قلنا. وقد يكون حساب الحجم الزمني أكثر دقة لتحديد الموجودات من المسافة الزمنية.
ب- تطبيقات أخرى: النقد الموسيقي للفن واللاهوت والتاريخ
إن الموسيقى، بما هي فلسفة للتطور الخالص، يمكن لها أن تمنحنا كذلك فرضيات بديلة عن منطق التطور في العمل الفني الواحد، أي النقد الموسيقي للعمل الفني، سواء كان لوحة فنية، أو رواية، أو قصيدة، أو عمارة. وهو نقد مؤسس على حقيقة الصيرورة، باعتبارها الحقيقة الوحيدة الممكنة في زمن العالم الافتراضي. ويمكن أن يمتد هذا التطبيق كذلك إلى الميتافيزيقا وتصوراتنا عن الألوهية، شريطة أن يتم نفي السرمدية. هل يمكن مثلاً تصور الواحد الأفلوطيني متطورًا؟ وبأي شكل؟ وإلى أي غاية؟ إن فكرة الصيرورة نفسها قائمة، ومتجذرة في فلسفة أفلوطين، في مستوى يبدأ بَعد النفس الكلية، فكيف وقع هذا التطور من خلال دراستنا لأنماط التطور الأساسية على الأقل في الموسيقى؟ وهذا قد يمتد بالطبع إلى فلسفة التاريخ، فيما يتعلق بنمط تطور المجتمع، والظواهر الإنسانية، بأسلوب معين. هل يتحرك التاريخ دائريًا أم جدليًا؟ هل هو ذو غاية وخطة، أم أن كلاً من الغاية والخطة سوء فهم، أم هما في دائرة الاحتمال أبدًا؟
ج- النظام في الفوضَى
الموسيقى هي الفن الأهمّ في سياق توجيه الوعي إلى التساؤل عن النظام في الفوضَى؛ نظرًا لأنها – كما ذكرنا في مقالات سابقة – الفن المميز بالنظام. كما رأينا سابقًا فإن الموسيقيين يتفاوتون في درجة النظام، ونوع حضوره بشكل عام. إن التأويل الموتسارتي للطبيعة يفترض وجود قوانين محددة لها، وهو في هذا يتشابه بشكل عام مع التأويل البيتهوفني؛ فكل منهما يؤكد حضورَ نظام ما في العشواء، بحيث تكون باستطاعة البشر فهمه والتناغم معه، وربما إبداله (بالذات عند بيتهوفن)، وتأسيس نظام جديد. لكن الحال يختلف بالمقارنة مع كل من رحمانينوف وشوستاكوفتش؛ فالنظام عند رحمانينوف مرتبط بالغاية منه، بمعنى أن محاولة العثور على نظام في الفوضى يجب أن ترتبط لديه بفهم الغاية، وليس السبب فحسب. أما في حالة شوستاكوفتش فإن في محاولة العثور على نظام أصلاً كثيرًا من الشكّ، وقد تكون مزيدًا من الإيغال في العبثية، لكنها قد تكون وجيهة أيضًا إذا تذكرنا حضور الآلة clockwork لديه، فالكون قد يكون منظمًا كآلةٍ لكنه بلا غاية، وبحيث يكون هذا النظام باطنيًا غائمًا طيلة الوقت والتاريخ.
د- هل الموسيقى موجودة؟
إذا قلنا أن الموسيقى صيرورة خالصة، فإن نتيجة هذا القول اعتقادنا أن الموسيقى غير موجودة طبيعيًا؛ لأن نمط الحركة/ التغير ذلك موجود ذهني بحت، حتى وإن كانت الأصوات التي تستدعيه قائمة فيزيقيًا في الزمكان، تمامًا كما نقول (س + س = 2س)؛ فهذه الحقيقة الرياضية الأخيرة غير موجودة في الطبيعة، رغم أن رسمها على هذه الصفحة موجود فيزيقيًا، وإلا فمتى، وأين؟ وعن طريق هذه الأبنية النظرية المجردة يقوم العقل بفهم الطبيعة. ونظرًا لأنها طبيعة مشتركة في العقل البشري ذاته، أو – بالأحرى والأدق – اختيار عام، وقرار مشترك، فإننا لا نختلف بصددها. وإذا اعتبرنا الموسيقى إنتاجًا لنمط حركة، أي إنتاجًا لزمن بديل، وتلاعبًا بالزمن، فكأننا نقول – بناء على ما سبق – أن الموسيقى وجود ذهني بحت.
كيف يمكن أن نقول أن الموسيقى وجود ذهني بحت، لا محل له في الطبيعة، إذا كنا نسمع الموسيقى فيزيقيًا، ونراها وهي تُعزَف؟ في الواقع إن ما نسمعه، ونراه، هو مجرد ما يستحث الوجود الذهني للعمل، فبدون معرفة بصيغة الصوناتا والتنويعات والمينويت والإسكرتسو والروندو.. إلخ، فلن نستمع سوى إلى مجموعة ألحان غارقة في ضوضاء، وهو أول ما يفهمه المستمع غير الخبير بالموسيقى الكلاسيكية منها بالمناسبة! ولهذا فالعمل الموسيقي فعلاً غير موجود في الطبيعة، وإنما في العقل. وكل ما هو موجود في الطبيعة منه مجرد أصوات، لا تأتلف إلا في العقل البشري، وبناء على صيغة معروفة مسبقًا، وأذن مدربة على سلم موسيقي، ومقام، ونظام للهارموني، وصيغ فنية.
فهل يعني ذلك كله في النهاية أن الموسيقى موجود مثالي بحت، غير واقعي، لا وجود له إلا في العقل؟ الحقيقة أنْ لا؛ لأن الصيرورة كما قلنا هي الحقيقة الوحيدة في عالم اليوم، هي الكوجيتو، أو بالأحرى، “الفِيُو”، الوحيد الممكن حاليًا في عصر الواقع الافتراضي، والذي لا يتأسس عليه شيء. ولو كنّا عقولاً تحلُم، بلا أجساد، ولا طبيعة، فلا معنى هنا للمثالي، والواقعي. في الواقع لقد انهار الواقع، وانهارت معه هذه الثنائية، وما يتبعها من إشكاليات، وبقيت الصيرورة الخالصة: الموسيقى، موجودًا وحيدًا أكيدًا في عالم اليوم.
صورة الغلاف: لوحة خلق العالم والنفي من الفردوس للرسّام الإيطالي جيوفاني دي بابلو، ١٤٤٥.
المصادر والمراجع:
- Academic American encyclopedia, Volume 6, Grolier Incorporated, Danbury, Conn, 1990.
- Also cf. Gorham, Geoffrey, “Descartes on Time and Duration”, Early Science and Medicine, Vol. 12, No. 1 (2007)..
- Aristotle, Physica, trans. by R. P. Hardie and R. K. Gaye, Clarendon Press, Oxford, 1966.
- Barbour, J. The End of Time-The Next Revolution in Physics, Oxford University Press, 1999.
- Bostrom, N., “Are you living in a computer simulation?”, Philosophical Quarterly, (2003,) Vol. 53, No. 211.
- Davis, Erik, “Synthetic Meditations: Cogito in the Matrix”, in: Darren Tofts, Annmarie Jonson, Alessio Cavallaro, (eds.), Prefiguring Cyberculture: An Intellectual History, MIT Press, 2003.
- Descartes, René, “Principia Philosophiae”, Oeuvres de Descartes, Publiées par Charles Adam & Paul Tannery sous les auspices du Ministère de L’instruction Publique Librairie Philosophique J. Vrin, Paris, VIII, pars prima.
- Descartes, René, Meditationes de Prima Philosophia, C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, Oskar Beck, München, 1901, “Meditation Seconde”.
- A., “Die Grundlagen der allgemeinen Relativitätstheorie”, Annalen der Physik, vierte Folge, Band 49, 1916.
- Grünbaum, A., Philosophical Problems of Space and Time, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht-Holland/ Boston-U.S.A, 2nd edidtion.
- Heidegger, Martin, Sein und Zeit, Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 19. Auflage, 2006.
- Kant, Immanuel, Kritik der reinen Vernunft, herausgegeben Benno Erdmann, Verlag von Leopold Voss, zweite Stereotypausgabe, Leipzig, 1880.
- Locke, John, An essay concerning human understanding, printed for Thomas Tegg, Dublin, 25th edition, 1825.
- Minkowski, H., Space and Time-Minkowski’s Papers on Relativity, Minkowski Institute Press, 2001.
- Minkowski, H., Space and Time-Minkowski’s Papers on Relativity, Minkowski Institute Press, 2001.
- Newton, Isaac, The Mathematical Principles of Natural Philosophy, Translated into English by Andrew Motte, Printed for Benjamin Motte, at the Middle-Temple-Gate, Fleet Street, 1829..
- Plotinus, The Enneads, translated by Stephen MacKenna, Faber and Faber Limited, London.
- Reichenbach, H., The Philosophy of Space and Time, Dover, New York, 1958.
- Russell, B., Our Knowledge of the External World- as a Field for Scientific Method in Philosophy, George Allen & Unwin Ltd., London.
- Schoen-Nazzaro, M. B., “Plato and Aristotle on the Ends of Music”, Laval théologique et philosophique, Volume 34, numéro 3, 1978.
- Schopenhauer, Arthur, Die Welt als Wille und Vorstellung, erster Band, vermehrte und verbesserte Auflage, Leipzig (Brockhaus) 1844.
- Thomas Aquinas, Commentary on the Metaphysics of Aristotle, volume II, trans. by John P. Rowan, Henry Regnery Company, Chicago 1961.
- Woodard, Susan Jeanne, The Dies irae as used by Sergei Rachmaninoff: some sources, antecedents, and applications, Ohio State University, 1984.
- عبد الرحمن بدوي، الزمان الوجودي، دار الثقافة، بيروت، ط3، 1973.