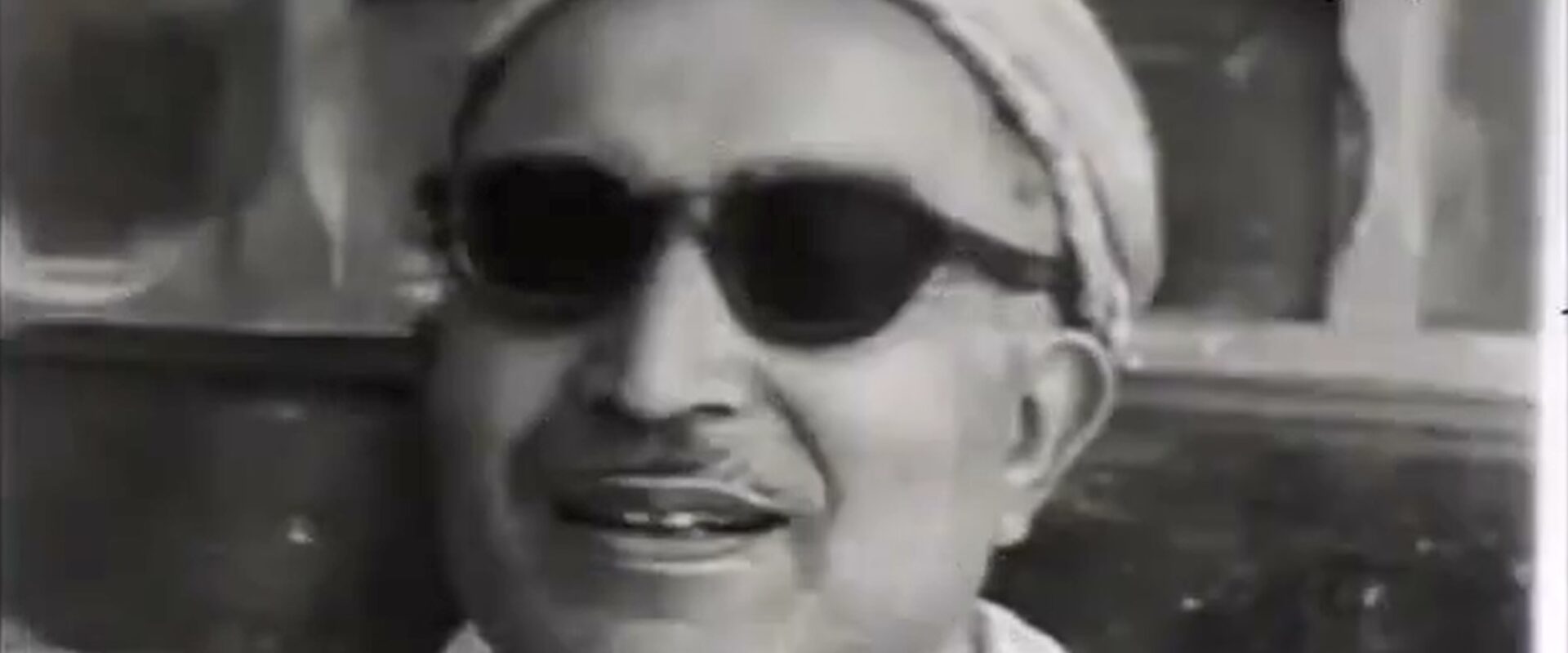
كنت آنذاك طفلًا، حافي القدمين على الأرض الناعمة، وأذناي تستمعان إلى صوت بالغ الألفة انطلق من جهاز التلفزيون الصغير، صوت علي البراق مرتلًا القرآن، وممتدًا عبر المنزل كشريط من الضوء.
تغلفني تلاوته العميقة وتملأ كل ركن، وتتسلل بين حفيف يدي أمي وهي تعد الشربة بعنايةٍ. يتحول صوت البراق وحركة عمل والدتي الهادئة لحنًا واحدًا، مقدسًا وغير منقطع؛ أما أبي ، فقد كان وجهه، الذي عركته سنوات الغربة والقسوة، يلين في تلك اللحظات، وكأنه يعود يافعًا مرة أخرى وهو يتلو أوراده؛ وبينما يتصاعد صوت علي البراق كالبخور إلى نغماته الأخيرة، تستدير أمي فجأةً، وعيناها دافئتين وصوتها لطيف: “تعال يا بني. لقد حان الوقت.”
كنت أستيقظ وقلبي ممتلئ بشيء لم أستطع تسميته حينها، لكنني أعرف الآن: إنه الانتماء، والإيمان، ونعمة أن تسكن اللحظة خالي القلب والعقل من أي همّ. ثم مع تقدم الزمن وازدحام القلب والعقل وضياع ذلك الفردوس، صار علي البراق أحد الأشياء التي تربطني بتلك الذاكرة الغضة والسعيدة؛ وكلما تقاطعت دروب أذناي مع صوته يعود ذلك البيت الصغير وتلك المساءات الرمضانية، وذلك الوالد الذي رحل بعيدًا والأم اليافعة، التي أصبحت جدةً، دفعةً واحدةً.
لا يتعلق الأمر بي فحسب. شكّل علي البراق، وما زال، أحد أساسات الذاكرة الدينية لأجيالٍ من التونسيين. لكنه لم يصبح المقرئ الذي نعرفه، ولم يحافظ على موقعه في الثقافة التونسية الدينية / الإنشادية، لأن صوته جميل فحسب؛ إنما لعبت السياقات التاريخية والسياسية التي سلكتها الدولة الحديثة دورًا أساسيًا في تأبيد شهرته وحضوره، حتى صار مقرئ تونس الوحيد والأخير، ومؤذنها الأثير.
الفتى القيرواني في الحلفاوين
عند الفجر، كانت مدينة تونس تتحرك كقطة نائمة، تبسط أطرافها تحت أول ضوء. ما زالت أزقة حي الحلفاوين رطبة بنسمات الليل، تحمل رائحة الخبز الطازج وملح البحر البعيد. في هذه الساعة، قبل أن تلقي الشمس بنظرها بالكامل فوق أسطح المنازل، وصل علي البراق من القيروان، حيث ولد في ١٨٩٩، يدق بعصاه برفق على الطريق المرصوفة بالحصى.
كان قد أصيب بمرض صبيًا أخذ بصره، لكنه شحذ كل حواسه الأخرى. لم تفلحّ محاولات والده الحلاق، والذي يحترف العلاجات الطبيعية، في ردّ بصره وربما زادت الأمر تعقيدًا. مستسلمًا للقدرّ، سلك البراق باكرًا طريق التعليم الشرعي، وقد ساعدته البيئة القيروانية العلمائية على ذلك.
احتضنت جدران الجامع الأعظم – جامع عقبة بن نافع – صوته منذ كان طفلًا؛ ورغم مأساته، إلا أنه كان يسترشد بشيء أعمق من البصر، فقد تعلم كيف يبحر في العالم من خلال الصوت.
جعله حفيف جريد النخيل في الفناء، وأصوات المصلين وهمس الآيات، يرمم إدراكه الناقص للعالم؛ فضلًا عن مجالس السماع الصوفية، التي تردد عليها منذ الطفولة، ثم أصبح جزءًا منها يافعًا، والتي أمدته بذخيرةٍ ثريةٍ من حسن الإنشاد ومعرفة المقامات واستظهار دواوين المديح النبوي والصوفي عن ظهر قلبٍ. كما أنارت هذه المجالس ربما وحشة الظلام في عالمه الداخلي.
عندما بلغت شهرته تونس العاصمة، دعاه صديقة حمودة أبو سنّ، الرجل الذي شغل موقعًا هامًا في حركة المجتمع الأهلي التونسي في النصف الأول من القرن العشرين، وساهم في تأسيس الكثير من الجمعيات الثقافية والدينية والرياضية، لينّزح إلى العاصمة حيث أصبحت القيروان على اتساعها صغيرةً على أحلامه.
بعدما شد الرحال إلى الحاضرة، كما كانت النخب تسمي عاصمة البلاد، قرر النزول في الحلفاوين، أحد الأحياء الفرعية لحي باب سويقة الكبير. كان باب سويقة وتفرعاته جزءًا من الربط، أي داخل أسوار مدينة تونس القديمة، ومركزًا ثقافيًا مفتوحًا استقرت فيه النخبة التونسية الجديدة.
في ذلك الحي فتح الحبيب بورقيبة أول مكتبٍ له لممارسة المحاماة بعد عودته من فرنسا، وفيه نشأت وانتشرت جماعة تحت السور الأدبية، التي ضمت صعاليك الشعر والأدب التونسي في ذلك الوقت، وفيه تطورت المقاهي الغنائية بداية من عشرينيات القرن الماضي، والتي عرفت بـ الكافي شانطة Les cafés chantants، مثل صالة قرطبة وصالة الفتح، اللتان تخرج منهما مجموعة من مشاهير الغناء في تونس، مثل حسيبة رشدي وفتحية خيري وفضيلة ختمي وعلي الرياحي ورضا القلعي وغيرهم.
هذا فضلًا عن كون باب سويقة مستقرًا لطبقة من الشيوخ، ولعدد من المساجد ذات الحظوة والتأثير، أبرزها جامع يوسف صاحب الطابع، حيث استقر علي البراق إمامًا للتراويح في رمضان.
من شدة تأثير هذا المكان في التشكيل الحديث لتونس، طرح الرئيس الحبيب بورقيبة مرةً فكرة توحيد اللهجات التونسية في لهجة واحدة على طريقة فرانسوا الأول في فرنسا – كونه شديد التأثر بالنموذج الفرنسي في هندسة المجتمع – واقترح أن تكون لهجة باب سويقة أو “سُّرَّة تونس”، كما يحب أن يسميه، هي اللهجة الرسمية محمد الصياح - الفاعل والشاهد، حوار مع المولدي الأحمر - ص ٢٣٠، سراس للنشر ٢٠١٢.، لأنه يعتقد أنها جمعت على مدى عقودٍ أجيالًا من التونسيين قدموا إليها من أماكن شتى وثقافاتٍ مختلفةٍ وصهرتهم في نسيجٍ واحدٍ.
في رمضان، وعندما شرع في هجرته بعيدًا عن القيروان، سلب عقول من صلى خلفه في جامع صاحب الطابع، حتى أصبح جزءًا من أركان حي الحلفاوين. يسير فيها تتقدمه عصاه، وكأنه يعرفها منذ الأزل. كان يستطيع أن يحدد مكانه من خلال رائحة شجرة ياسمين، أو من ملمس حجر تحت أطراف أصابعه، أو من ضحكات الأطفال الذين يلعبون بالجوار.
في المساء، عندما تذوب السماء في ظلال العنبر والبنفسج، كان يجلس على درجات المسجد، وعصاه تستقر بجانبه، وينشد، لا من أجل المال أو في سيبل الثناء، ولكن لأن العالم، حتى في ظلامه، يستحق أن يمتلئ بالنور.
في تونس نسج البراق علاقاتٍ واسعةٍ مع شيوخ جامع الزيتونة، لا سيما شيوخ الطرق الصوفية، وانخرط بقوةٍ في مجالس السماع، إنشادًا وتلقينًا وتعلمًا للمقامات. كما ربطته صداقة قوية مع عميد الموسيقيين محمّد التريكي (١٨٩٩ – ١٩٩٨).
تصادف ذلك مع تطور حركة الفن والغناء في باب سويقة، حيث دأبت المقاهي الغنائية في رمضان على تخصيص وقتٍ للأناشيد والمدائح الصوفية والنبوية، خاصة في ذكرى غزة بدرّ وليلة القدرّ؛ في عادة أخذت طابعًا عربيًا بدعوة فرقٍ ومجموعاتٍ في هذا اللون من الموسيقى من مصر وسوريا.
شارك البراق منشدًا في تخت الكثير من الفرق لكن لم يستقر في أي واحدةٍ منها. حتى جاءت فرصة الدخول للإذاعة التونسية في عام تأسيسها سنة ١٩٣٨، عندما نجح في اختبارات التلاوة، ليصبح قارئًا رسميًا للقرآن في الإذاعة، بدفعٍ قوي من مديرها الأديب والمؤرخ عثمان الكعاك (١٩٠٣ – ١٩٧٦). حينذاك طبقت شهرته الآفاق، حتى بلغت القصر الملكي، عندما طلبه ملك البلاد المنصف باي (١٩٤٢ – ١٩٤٣) ليقرأ القرآن في القصر ويصلي به التراويح.
ينقل المؤرخ التونسي، لطفي عيسى، أن البراق “أصبح في وقتٍ وجيزٍ من الذين يطيب للباي أن يتسامر معهم.” حتى بعد عزله من طرف الاحتلال الفرنسي، واصل خلفه محمد الأمين باي عنايته به. كما ربطت البراق في تلك الفترة صداقة مع المغني والمجود المصري، أمين حسنين الشيخ، الذي أقام في تونس حتى وفاته في الستينيات، وعرف بصداقته الغربية مع إرفين رومل، القائد النازي لحملة شمال إفريقيا.
مع رسوخ قدمه قارئًا ومنشدًا في العاصمة، استقر علي البراق في الخمسينات في فرقة محمود عزيز للسلامية، نسبةً للشيخ عبد السلام الأسمر دفين ليبيا، وهي أشهر فرق الإنشاد الصوفي في تونس، أسسها الشيخ عبد العزيز بن محمود عام ١٩٥٨، وضمّت عددًا من أبرز المنشدين في تونس مثل هادي النعّات وأحمد الشحيمي وصلاح التونسي وعبد الرحمان بن محمود أحمد الخصخوصي - الشيخ عبد المجيد بن سعد أو الأبعاد المتعدّدة، الجزء الأوّل - الثقافة الشعبية، العدد ٥٧، ٢٠٢٢.، وتعاونت مع الملحن المصري المقيم في تونس سيد شطاّ (١٨٩٧ – ١٩٨٥). بعد ذلك سلك مسلكُا آخر في تكوين فرقة مع صديقيه محمد صريح وحمدي عجاج أطلقوا عليها اسم فرقة الشيوخ الثلاثة.
مؤذن الجمهورية
ولدت أسطورة علي البراق – كما نعرفها اليوم – بعد استقلال تونس في ١٩٥٦. المفارقة أنها تحققت على يد الحبيب بورقيبة، الرئيس الذي أراد أن يصنع “أمةً تونسيةً لا شرقية ولا غربية من غبار الأفراد، القادمين من الشرق والغرب ومن كل مكان.”
كان بورقيبة انعزاليًا بذلك المعنى الذي يرى فيه تونس ليست جزءًا من أي أمة طبيعية أو عرقية أو دينية، وإنما هي أمة مستقلة تتأسس من خليطٍ من الثقافات. لذلك كان صارمًا في صدّ جميع الأشكال والمضامين الثقافية والإيديولوجية من المشرق العربي، لا سيما المذهبية والفكرية، وكثير الحرص على صياغة شكل مستقلٍ من العروبة والإسلام ذو طابعٍ تونسي. لذلك نصب من نفسه مجتهدًا دينيًا.
ابتداءً من عام ١٩٥٧، بدأ بورقيبة في تفكيك المؤسسة الدينية. ألغى المحاكم الشرعية ووحد التعليم العام، ووضعه تحت إشراف الدولة. كما حظر التعليم الشرعي خارج الإطار الرسمي. ثم جاءت الضربة الأكثر تدميرًا: تفكيك الأسس المادية للمؤسسة الدينية ومصدرها الرئيسي للقوة المالية – الأوقاف الدينية – بتأميمها.
بلغ الأمر ذروته عام ١٩٦٠، قبل أسابيع قليلة من حلول شهر رمضان، عندما ألقى بورقيبة خطابًا أمام حشد كبير من قادة الدولة ورجال الدين يتقدمهم المفتي، الشيخ كمال الدين جعيط وعميد جامعة الزيتونة الشيخ الطاهر بن عاشور وضيوف من العالم الإسلامي، دعا فيه التونسيين إلى الإفطار خلال شهر الصوم للمساهمة في “القضاء على الفقر والتخلف”، وطلب من المفتي إصدار فتوى تدعم رأيه Ahmed Nadhif - How a Scandalous Glass of Orange Juice Helped To Reshape Tunisian Politics - New Lines Magazine - April 5, 2024.
في الوقت نفسه لم يكن نهج بورقيبة في الصراع مع المؤسسة الدينية التقليدية، كمصطفى كمال أتاتورك في تركيا، من منطلق إلغائي، لكن كان يريد أن يصنع لدولته الجديدة مؤسستها الدينية الخاصة، والتي تناسب هواه وفكره. تركت هذه السياسة أثرًا سيئًا في المشرق على صورة الرئيس التونسي، كما شكلت البذور الأولى لبروز معارضة إسلامية ظهرت بعد سنوات على نحو أشد وأقوى.
في مواجهة المشرق، ولا سيما مصر الناصرية، التي كان يخوض معها صراعًا سياسيًا وإيديولوجيًا حادًا، أراد بورقيبة أن يثبت أن لتونس خصوصيتها.
في وقتٍ كان عبد الباسط عبد الصمد ومحمد صديق المنشاوي ومحمد رفعت، وغيرهم من القراء والمجودين والمؤذنين المصريين يسيطرون على الساحة، طلب بورقيبة من علي البراق أن يرتل القرآن بعد عصر الجمعة في الحرم المكي في موسم الحج عام ١٩٦٣؛ وقد ناله من ذلك مديح واسع وإشادةً كبيرةً. كانت حتى ذلك الوقت لم تبرز المدرسة الحجازية والنجدية في التلاوة كما هي مسيطرة اليوم.
جعل بورقيبة من الشيخ البراق مزارًا لضيوفه الكبار من المشرق العربي، إذ يروى أن عميد الأدب العربي، طه حسين، عندما زار تونس عام ١٩٥٧، وصف صوته بأنه يعيد المستمتع إلى “زمن البعثة والوحي.”
أما أم كلثوم، فقد زارته في مسجده بالحلفاوين واستمعت لتلاوته، وعرجت عليه مرةً ثانيةً في مقهى المرابط بالمدينة القديمة، لتسمع من أناشيده الصوفية، فأنشدها قصيدة الإمام الشافعي في مدح النبي: “لكم مُهجتي والرُوح والجسمُ والقلبُ / وكُلي لكمُ ملكُ وإني بكمُ صبُ.”
حتى عندما سمح بورقيبة – بعد امتناع طويل – بإذاعة الأذان في الإذاعة التونسية، كان قراره مشروطًا بأن يكون بصوت علي البراق. لم يرحل البراق عن دنيا الناس في ديسمبر ١٩٨١، حتى سمع صوته يذاع خمس مراتٍ كل يوم في الإذاعة الرسمية.
كان هناك شيء في تلاوته أشبه بالخلود، وكأنه ورث نفس الأسلاف. كان تجويده سحريًا وفي عمقه حزنٌ مديد، وكل مقطع مزين بتبجيل يمكن أن يجعل حتى أكثر النفوس قسوة تلين. لا يختفي، فهو باقٍ في جدران المساجد القديمة، وفي ذاكرة البلاد، أفراحها وأحزانها، وفي قلوب أولئك الذين ما زالوا يغمضون أعينهم ويستمعون.